أثلج صدري الشرح والدفاع الذي قدَّمه الأخ ماهر فايز، لما امتاز به من أدب مسيحي جم، وصدق وشجاعة. وقبل أي شيء آخر، لم يكن لا العنوان، ولا السطور التي جاءت تحت هذا العنوان تمس كاتب الترنيمة من قريب أو بعيد، بل هي تتصدى في الأساس لما تزرعه الكلمات في الوعي والإدراك الإنساني الذي لا يمكن أن يقدم بالمرة، وينمو ذلك النمو الذي وصفه رسول الرب بأنه “من الله” (كولوسي 2: 19)، إلَّا بثلاث حقائق هي من ثوابت الإيمان المسيحي:
الأولى: الانتقال من العموميات إلى ما هو خاص. وعلى سبيل المثال، سمعت هذه الترنيمة في كنيسة عربية هنا في انديانا، تقول كلماتها:
دم يسوع غالي وثمين
دم تشهد له الملايين
وسئلت الحاضرين، ما هو المقصود بالضبط، وما علاقة ذلك بالتحديد الكتابي نفسه عن دم يسوع، وما معنى “دم يسوع ابنه يطهرنا من كل خطية”؟ ولم أسمع رداً مسيحياً كتابياً؛ لأن ما يقال في هذا الصدد هو كلام عام بلا تخصيص يفتقر إلى الوضوح وإلى الهدف. غياب الوضوح وغياب الهدف يزعج ضمير أي إنسان مسيحي؛ لأن الدم = الحياة، ولأن الدم هو ما قُدِّمَ لنا وللآب، قُدِّمَ لنا “ذبحاً” كتعبير عن الحب اللانهائي، وللآب لكي يقدس ويخصص الإنسانية إلى ميراث الملكوت. ولم يكن الدم “ثمناً” دفعه الابن للآب، هذا تجديفٌ لا يليق.
الثانية: الوعي الإنساني لا يتقدم ولا ينمو إذا كان يسير في طريق العموميات، ويتحرك حسب ما تقدمه العموميات. وعلى سبيل المثال، درجنا على استخدام كلمة “عبادة”، وهي كلمة خاصة باليهودية والإسلام، في حين أنه لا عبادة في المسيحية، وإنما حسب العهد الجديد اليوناني – القبطي، لدينا كلمة “خدمة”. حاول أن تسأل الفريق الذي يخدم معك يا سيدي العزيز: هل يخدمنا الثالوث في الابن والروح القدس، أم أننا نحن الذين نخدم الثالوث؟ وسوف أترك لك مجال الرد؛ لأن البحث الرائد الذي قمت به هنا في أمريكا عن ذات السؤال جاء بردود غير مسيحية وغير متوقعة من كبرى الكنائس.
نحن لسنا “عبيداً”، بل أبناء الآب الأحرار في يسوع. وعندما يصف رسول الرب نفسه بأنه “بولس عبد يسوع المسيح”، فهو يقصد أن الرب اقتناه كما يقتني السيد في المجتمع الروماني القديم العبد من “سوق النخاسة”. وبالرغم ذلك لا زال التعليم بالعبودية سائداً رغم أننا نُقلنا من العبودية إلى حرية أبدية في المسيح، وأترك لكم مراجعة الترانيم التي تصف هذه العبودية؛ لأن هذا هو حقل خدمتك الممتازة.
ومرة ثانية، أنا لا أقصد شخصاً معيناً، لا أنت أخي الكريم ولا غيرك. حاشا لي من قِبل الرب يسوع أن أُصدر حكماً على إنسان حتى ولو كان غير مسيحي.
الثالثة: لعلك تعرف ترنيمة “يا سائح للقاء يسوع”، والأخرى “يا من بحضوره نفسي تطيب”. مثل هذه الكلمات هي من العموميات التي تصيب الحياة الروحية بالضعف. أساس التسبيح هو الاتحاد بالآب بقوة الروح القدس، ولذلك، الضعف الروحي الحادث عندنا له مكونات لا بُد سبق لك أن رصدتها، وهي بالتحديد:
– اعتبار يسوع فكرة في العقل، مثل ما يقال عن الدم، وبالتالي التنازل عن يسوع الشخص أو الأقنوم. هنا تصبح العلاقة نفسانية عقلية تقع تحت سيطرة الفكر، تذهب هذه العلاقة وتجيء مع الفكر ومع الشعور؛ لأنها تفتقر إلى الأساس الأبدي، أي اتحاد الرب بنا اتحاداً أبدياً أصبح مهجوراً في زماننا يُمسُّ من بعيد.
– تحول يسوع إلى كائن آخر خارج إطار الحياة اليومية، فهو لا يشارك الأجساد والأرواح. هو في السماء، وعندما أسمع عبارة طلب الغفران على “حساب الدم الكريم”، أجد نفسي أمام أكبر مشكلة، وهي بالتحديد افتقار الخطاة إلى ينبوع الحياة الأبدية الكائن فيهم في يسوع؛ لأن التعليم بانفصال الخطاة عن الرب هو تعليم شائع هدم وأضعف الحياة المسيحية.
ما هي التقوى المزيَّفة التي تفتقر إلى الأساس اللاهوتي؟
أنا لا أطعن في تقواك الشخصية، لأن هذا موضوعٌ لا يخصني، وإنما يقع في إطار علاقتك الشخصية بالرب يسوع، وبالتالي ليس لي أن أحكم فيه على الإطلاق. وللمرة الثالثة لست أقصدك، بل أقصد ما زرعته الترانيم -بشكلٍ عام- من تيار شعبي يفتقر إلى الأصالة وإلى العودة إلى الثوابت.
طبعاً لديكم ترانيم جيدة عن تجسد الرب والصلب والقيامة والروح القدس، والثالوث (رغم ندرة ما لدينا من ترانيم عن المحبة الثالوثية)، ولكني أتصدى هنا للعموميات التي تزيِّف الحياة، وهي بالتحديد، تجعل الحياة تبدو مسيحية وهي ليست كذلك؛ لأن كل ترنيمة مهما كان كاتبها، ومهما كان انتماؤه الكنسي (وهذا لا يخصني)، لا تضع كلماتها خصوصية المسيحية في اعتبارها، لا بُد وأن تزيِّف الحياة.
– الكلمات التي تحول العلاقة بين المؤمن والمسيح إلى وصف خارجي للمسيح لا يصل بعد الوصف العام إلى ما يعطي دائما من الرب، تصبح كمن يصف مباراة كرة قدم، يمدح فريقها ولا يجيد اللعبة نفسها، ويكتفي بالمشاهدة. أعتقد أن هذا واضح. لكن وصف الرب بكل ما لدينا من أوصاف، إذا لم ينقل الوعي إلى ما نناله من الرب، عندئذٍ نسقط في فراغ روحي، لا يهم هنا مصدر الترنيمة أو حتى تاريخها؛ لأن القِدَم لا يعني الأصالة.
– وعندما نصف دون أن نشترك، أو يقتصر الوصف على الصلب والمصلوب وحذف القيامة، فإن ذلك يجعل الصلب والمصلوب يفتقد إلى العمق الأبدي الخالد والانتصار على الموت وإبادة الشيطان، الذي تحول في السنوات الأخيرة إلى قوة مساوية للمسيح يخاف منها الناس.
هذا هو التزييف الذي أقصده.
وثمة مسألة أخرى ذات دلالة هامة، ألا وهي أن كل كلام عن الله هو كلامٌ عام، لا يجب أن يقال عندنا مهما كان الانتماء الكنسي؛ لأن “الله” قضية عامة عند اليهود والمسلمين. “الله” عندنا هو الآب أبو ربنا يسوع المسيح. نحن نعيش في زمن اختلفت فيه الأمور، وقد عاتبت الأنبا شنودة الثالث -عندما كان لازال يسمعني- على تكرار استخدام عبارة “السيد المسيح”، وقلت له إن العبارة الصحيحة هي “الرب يسوع”؛ لأن كلمة “السيد” ليس لها مكان في اعتراف صحيح، والهرب من عار الشهادة عيبٌ كبير، ولكن الخوف واعتباراتٍ أخرى –أنت تعرفها- لازالت تحكم الكلام عن “السيد المسيح”، وليس “الرب يسوع”.
أنا لا أقصدك بالمرة، وإنما هذه هي الحالة العامة التي عندنا والتي يجب أن نتجاوزها.
العواطف الإنسانية العامة لا تكفي
يا ليت كان لديَّ ذات المواهب التي لديك في الكتابة والموسيقى والصوت العذب. إن تسبيح حقائق الأبد التي جاءت إلينا في يسوع رب المجد، ليست عواطف تذهب وتجيء، بل هو الإيمان بما فيه من إرادة توصف في اللاهوت الشرقي بأنها “تتأله”، أي تنال الثبات الإلهي والدعم بالنعمة. الشوق إلى الله هو شوقٌ طبيعي، وقديماً قال العلَّامة ترتليان: “إن النفس الإنسانية مسيحية لأنها خُلِقت على صورة الله، فهي مدعوة لأن تفهم حقيقة خلقها على صورة الله”. لكن –يا أخي الكريم- تحريك العواطف والانفعالات يقود إلى فراغ روحي لا يصل إليه “العابدون”. وعلى سبيل المثال لا الحصر، كم مرة سمعنا مزمور 23 “الرب راعيَّ”؟ المزمور كُتِبَ تحت روح العهد القديم، يفتقر إلى ما ورد في إنجيل يوحنا ص 10 عن الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف، ولذلك، العاطفة التي تقول:
راعيَّ العظيم نفسي تتبعك
ما أجمل صوتك لي
هذه العاطفة، تنسى ذبح الإرادة الإلهية على الصليب، وتنسى بسبب صياغة الكلمات أن المذبوح يأتي إلينا دائماً؛ لأن ذبح الإرادة صار قوة حياة بسبب القيامة، وهو ما توحي به الرسالة إلى العبرانيين.
إن حركة بحث الإنسان عن الله هي حركة مضادة للتجسد والصلب والقيامة وانسكاب الروح القدس. ولكن بحث الله الآب عن الإنسان، والسعي الدائم إليه هو التعليم المسيحي. تأمل معي –يا سيدي الكريم- هل وصل الإدراك عندنا إلى أن عبارة الذوكصا: “المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين”، لا يمكن أن يكون المقصود منها تمجيد الثالوث فقط، بل نحن ننطق بالمجد لأننا اشتركنا فيه؟ وعندما “يعترف كل لسان بأن يسوع ربٌّ لمجد الله الآب”، فهذا لا يمكن فصله عن قول الرب: “المجد الذي أعطيتني قد أعطيتهم”.
هل تصل بنا الترانيم المعاصرة إلى تأكيد أننا ننال نعمة غير مخلوقة، نعمة إلهية، وأبدية، ودائمة، أم أننا حاصرنا الإنجيل في بشارة بعواطف سامية نبيلة فقط؟
لم أتهمك بأنك تعلِّم “بالفناء”، ولكن ترك أو التخلي أو نسيان القلب، أو أي تعبير آخر من هذا القبيل هو تعبير ينطوي على خطورة. فقد جاء المسيح رب الحياة لكي يجعلنا بشراً بقلوب لحمية، وبقلوب تنال صراخ الروح: “أبَّا أيها الآب”. واختلاط جحد الذات بتدمير وكراهية الذات، بل انعدام محبة الإنسان لنفسه هو تعليم شائع مدمر؛ لأن الوصية العظمى الثانية تقول: “حب قريبك كنفسك”، وهكذا صارت محبة الإنسان لنفسه في المصلوب، وفي المصلوب وحده هي المحبة الحقيقية، وهي ليست كراهية النفس أو الذات كما تعلم.
أتمنى أن تكون رسالتي قد وصلت؛ لأن التيار الشعبي العام يجب أن يتوقف، وأن تصبح خصوصية المسيحية، ونقل الوعي إلى الاتحاد بالرب يسوع هو هدف ما نسميه “العبادة”.
أكرر شكري على أسلوبك النقي، وأرجو أن نستمر في الحوار، والمحبة غالبة لكل ما لدينا لأنها انتصرت على كل أشكال العداوة في يسوع المسيح ربنا الذي فيه أُرسل لك تحية الاحترام والمحبة الأبدية.
دكتور
جورج حبيب بباوي


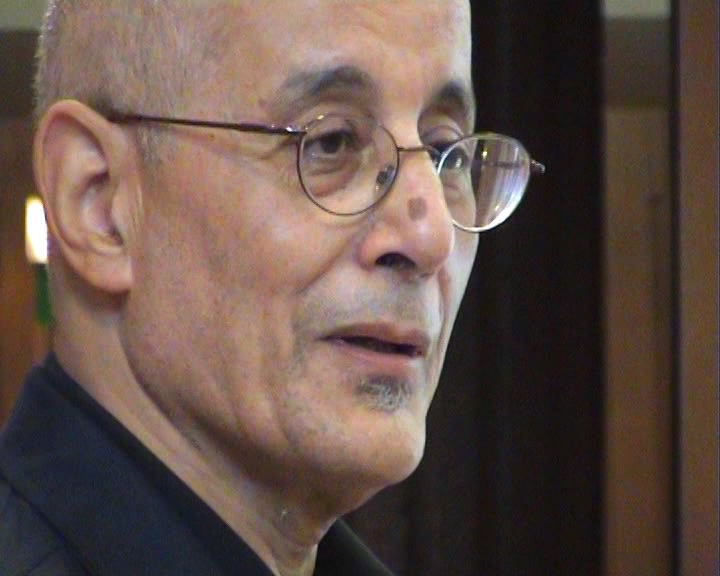

9 تعليقات
Thank Dr. George Bebawi for that wonderful academic and spiritual answer. I wish we all engage in such civil exchanges that doesn’t lead to hurt or confusion.
Peace
تسبيح الروح والحق ’1’
——————————
إلى العزيز الكاروز ماهر فايز الذى امتعنا طويلاً بعذوبة صوته ورقة كلماته الروحية.
إن هناك سؤال هام نبحث له عن إجابة منذ زمناً ليس بقليل, وأرى انه من الأمانة ان نبحث سوياً, لأن رجاءنا جميعاً فى الحق لا ينقطع, ولئلا نكون مقصرين ومفرطين فى النعمة والموهبة المعطاة لنا كأمانة وكوزنة, التى سيستردها يوماً ما السيد!
السؤال هو .. هل هناك فارق بين التسبيح والعمل الفنى؟
اسمح لى ان اضع بعضا من النقاط البسيطة على طريق البحث التى يمكن لها ان تعيننا سوياً:
أولاً: ليس الفارق بين التسبيح والعمل الفنى هو الكلمات, لأنه بكل بساطة يمكن ان يتفق الأثنين على ذات الكلمات, إلا إن الفارق سيظل قائماً, فمثلاً الست أم كلثوم كوكب الشرق, كانت تغنى بذات الكلمات التى يستخدمها الأحباء والعشاق, إلا إن الفارق قائماً, وإلى الأبد واضحاً, بين غناء طربنا له, وبين عشق سكرنا بكلماته, هى هى نفس الكلمات ولكن الفارق عظيم وواضح!
وهذا ما قد أشار له د جورج بنصيحته الصائبة, بانه يجب علينا ان نترك العموميات لندخل إلى ما هو خاص. إلى الإتحاد بالمسيح بقوة الروح القدس.
إذاً الإشكال ليس فى الكلمات بل فى غياب الإتحاد, والكلمات ستظل مجرد حروف إن لم تأتى من وإلى كيانية الإتحاد. ليس بمجرد ذكر اسم الروح القدس يأتى البنون!! فبنوتنا لله فوق كل الكلمات والحروف مهما بلغ تقديسنا لها.
ثانياً: كلمات الترانيم هى ابتكار اختبار شخص واحد, يضخ إياها فى دماء الكنيسة, مجدداً مقوياً خدمتها, فهل خدمة الرب يسوع تحتاج لضخ كلمات متجددة باستمرار, هل التجديد مطلوب؟
وهل الموهبة الابتكارية تنتج فناً ام تسبيحاً؟
وإن كانت الكنيسة فى إحتياج دائم لشخص, يضخ كلماته فى دمائها, آلَاَ يكون هذا سبب مصابنا.
ثالثاً: تتميز كلمات التراتيل بالسهولة والوضوح والبساطة الشديدة, التى تشكل مرحلة ما قبل الفناء اللغوى, فهى كلمات مهضومة مسبقاً, فقد هضمت بواسطة كاتب الترنيمة, فقد كانت قبلاً فكراً لاهوتياً كاملاً, عميقاً تم إختزاله فى بضع كلمات بسيطة شعبية متداولة, لضمان الإقبال الشعبى عليها وحفظها وتريددها, أليس هذا هو الأختصار المخل للمعنى والهدف؟! ’’سقيتكم لبنا لا طعاما لانكم لم تكونوا بعد تستطيعون بل الان ايضا لا تستطيعون’’ 1كو 2:3
رابعاً: حينما يصل عدد الترانيم لعشرات الآلاف, هذا يشكل مبعثاً للفرقة والتشتت, بل والإنقسام والخلاف, فهل هناك من إحصائية لعدد الترانيم المستخدمة فى البروتستانتية, اعتقد إن وُجدت ستكون باعداد مفزعة خيالية, ووقتها سنعلم يقيناً أحد أسباب انقسام وتشتت الطوائف البروستانتية بهذا الشكل المخيف. الذى يتعاض تمام التعارض مع وحدانية جسد المسيح!
وكم آمل ان تكون الحكمة والرؤية البعيدة لدى قيادات البروتستانتية متوفرة, فيجتمعون كأخوة, ليبحثوا سوياً سبب تفتتهم, التى لعبت كثرة الترانيم دوراً فيه بلا ادنى شك, لعدم وجود تسبيح محدد, مقنن مختبر مفحوص معروف لدى المجموع البروتستانتى, فصار التسبيح بحسب موهبة واختبار الشخص المرنم, فكل مجموع أجتمع للترنم, يعيش عصر مرنمه الخاص به, ليأتى بعده موهوب أخر, بموهبة جديدة, بمذاق أخر مختلف, فينقسم المجموع إلى جماعات اصغر, وهكذا دواليك على طول الزمان, فمن المؤكد إنه مع كثرة وتراكم الانتاج الفنى لمواد التسبيح, ستتعارض حتماً هى نفسها مع بعضها, مع تقدم الزمن, وتغير الاتجاهات البيئية لكل إجتماع. وكم من مرات حضرنا خلافاً شديداً يصل لحد الفرقة والقطيعة, بين اثنين من المصليين من ذات الإجتماع, على خلاف تفسيرى لكلمات ترنيمة ما, واستشهاد احدهم بكلمات لترنيمة أخرى تتعارض مع الترنيمة الأولى. فللأسف مع مضى الوقت تصبح الترانيم هى ذاتها حجة وشهادة!
خامساً: هذة المرة الأولى التى اسمع فيها تصنيفاً لاهوتياً للتسبيح, فهناك انواع واصناف من التسبيح كثر, تسبيحاً خاصاً بالاهوت العقيدى, وأخر للاهوت الخلاص, وهذة هى المرة الاولى ايضاً التى اسمع فيها ان هناك لاهوت للخلاص خاص به, اليس الإكثار من التصنيفات هذة للتسبيح مدعاة قوية للتفتيت والفرقة.
سادساً: فى مرة من المرات سمعتُ منك تفريقاً بين التسبيح والترنم, فقلت بما معناه ان التسبيح شئ خاص يقدمه الانسان لله, اما الترنم فهو شئ خاص يقدم فيه الانسان احتياجاته الخاصة, فإن كان الامر كذلك, أليس من الافضل الفصل المكانى بين الأثنين, الكنيسة للتسبيح فقط, وقاعة كمسرح مثلاً للترانيم, لتبقى الكنيسة فى عيون الجميع بعيدة عن فكر الإنقسام والفرقة . وإن كان هناك فارق بين التسبيح والترنم, فكيف يكون التسبيح إذاً؟؟
سابعاً: دائماً اسمع منك وعنك, بانك دارس جيد لأبونا متى المسكين, وكذلك الامر عن د سامح موريس, بل والكثير من أقطاب البروتستانتية يرددون نفس المقولة, وحتى الآن لم يشرح لنا أحداً, كيف تم ذلك ؟ وإلى أى مدى؟ فهل ابونا متى المسكين هو الذى قد اتفق مع الفكر البروتستانتى, أم ان البروتستانتية هى التى تغييرت فى فكرها, لحد انها تتفق مع فكر راهب أرثوذكسى ناسك متوحد, ام إن الإمر لا يتعدى سوى إستخدام لأسماء المشاهير الارثوذكس, أم ان ترديد أنصاف الحقائق يدمر النصف الأخر!
ثامناً: وبما انك من دارسى أبونا متى المسكين, فهل تتفق معه فى عدم أستخدام الموسيقى فى التسبيح؟ والتى ما نصح بها قط؟ فالموسيقى الصاخبة تعتبر وسيلة جيدة للجذب السريع, فمن منا ما سمع صوت موسيقى فى الشارع, وإلا توقف وأنصت, ونرى ان الفقراء والمحتاجين فى بلاد الإفرنجة, يستخدمون الموسيقى ليلفتون الإنتباة إليهم, اذاً الموسيقى عنصر جذب شديد.
أما إن أردت الحق, فأن الموسيقى الصاخبة العالية تعيق مرحلة من أهم مراحل النمو الروحى, وهى مرحلة الإستبطان, كما اكد عليها ابونا متى المسكين مراراً وتكراراً, فهى تشكل النمو الحقيقى للمؤمن, التى يستبطن فيها المؤمن كلمة الرب لحساب حياة وسلوك بالروح والحق, إذاً الإبهار السمعى بهذا الشكل يعيق الإستبطان الذهنى لكلمة الرب, فنربى أجيالاً منفعلة بالظاهر وبالمظاهر, دون نمو حقيقى للجذور, فيسقطون إن هبت الرياح!
وتحت تأثير الموسيقى الصاخبة وحدها, ينفعل الانسان بفرح لحظى شديد, فيتقبل ما لا يتقبله فى حالته العادية!!
فهل الهدف هو الإقناع اللحظى للبشر بأهمية الحياة فى المسيح يسوع؟
أم ان الهدف هو النمو الباطنى العميق, والأقتناع الشامل الذى يشمل كل الحياة؟
الكنيسة تبنى بنفوس البشر, وليس بانفعالات البشر؟
تاسعاً: الغناء مثلاً له مقومات ثلاث اساسية هى الموسيقى والكلمات والصوت العذب, فهل التسبيح له ذات المقومات؟ إن غياب الموسيقى والصوت الحسن لا ينهى تسبيحاً, فالتسبيح لا ينتفى بدونهما!, فمقومات التسبيح قلب صادق وكلمات.
سيدى الكاروز .. هل تستطيع الكنيسة البروتستانتية ان تخدم فى إجتماعاتها العامة بكلمات الترانيم فقط بدون موسيقى, وبمجرد صوت عادى, بدون إمكانيات تطرب السامع, إن فعلتها فبالحق سيكون هذا هو تسبيح القلب, والقلب فقط بلا اى مؤثرات صوتية أخرى تشوش على العمل القلبى العميق.
لقد حضرتُ شخصياً لك الكثير من اللقاءات العامة المختلطة او الشبابية, والتى كنت تعقدها فى مختلف الكنائس والبلدان على مدار سنوات كثيرة, وكنتُ انصرف ومعى جمهور كبير من المدمنين مثلى, عندما كنت تعتذر عن الحضور لسبب او لأخر, فبالحق لك جمهور عريض يدمن عذوبة صوتك, ورقة مشاعرك, وحلو كلماتك, وشرقية الحانك, وتمكنك من العزف على العود, آله السحر لدى المصريين!!
فها أنا اعترف بأدمانى لعذوبة صوتك, واعترف ايضاً باننى اسمعك فى سيارتى, حتى درجة الثمالة!
إلا ان السؤال ما زال قائماً هل هناك من فارق بين التسبيح والعمل الفنى؟
السيد سوستانيس اسمح لى ان اسجل اعجبى الشديد بكل هذا الطرح المهذب والشديد الوضوح والتركيز فهذا هو تماما ما اره فى هذا الامر ولكنى اضيف ايضاً أنه مما يبعث على الحزن والاسى أن يكون الخادم خادم الى أن تختلف معة فيتصلف ويبرر ذاته ويعدد افضالة على الخدمة التى هى اصلاً ليست من حق أحد أٌقصد خدمة النفوس سوى ربنا ومخلص نفوسنا يسوع المسيح وهو يشركنا معه فيها من فرط حبه لنا لا عن استحقاق مهما كانت موهبنا او كفأتنا لاننا نخدم من نعانى مثلهم من وطئة الخطايا وليس فيهم من يحق لنا أن نعتبرهم انصاف متعلمين.
شكرا على الموضوع و الردود
هو ماهر فايز موهوب و صوته عذب و رجل مختبر للترانيم اللى بيقولها
و لكن يبقى الإعتراض على محتوى التسبيح الذى يقدمه من وجهه نظر أرثوذوكسية
و أيضا التحليل الذى قدمه سوستانيس
تحليل جيد يحاول أن يبين فيه – على حسب فهمى لنص التعليق – أن التسبيح البروتستانتلى عموما لا يتفق مع علو اللحن و التسبيح الأرثوثوذوكسى
الحقيقة أن غياب الليتوجية عموما و ليتورجية الأفخارستيا خاصة فى البروتستانتية هو السبب و أرجو أن يعلق الدكتور جورج على كلمتى هذا
الأستاذ عادل هنرى
———————–
شكراً لك على المشاركة التى أوضحت عنصراً جديداً, رغبنا من البدء تجاهله, إلا ان هذا هو الحق المكتوم عنه, وهو أصل مصابنا فى البروتستانتية, التى أتت لبلادنا محاولة بكل جهدها ان تغسل تاريخها المادى الدموى, لتمحو فشلها فى مسقط رأسها!!
نحن لا نحمل كراهيةً لأحد, ولكن على طالب الغسيل لتاريخه, ان يقدم اعتذاراً أولاً, عن كل الأخطاء التى أرتكبت فى الماضى, ضد قداسة الأنسانية فى كنيسة المسيح, ليعرف الجميع مع من يتحدثون؟ بالضبط كمطالبة المجتمع الدولى لتركيا بتقديم أعتذاراً رسمياً عن مذبحة الأرمن الشهيرة. هكذا فقط تطوى صفحة من التاريخ, لتبدأ صفحة جديدة!!
فالحقيقة التى لا ينبغى لها وجود فى مستقبل خدمة المسيح, عن هؤلاء الخدام الذين يعددون أفضالهم على الخدمة, هى حقيقة تشابك المصالح المادية مع الخدمة ذاتها, ومع المسؤلين عنها إدارياً, فيغدون البصر والسمع أيضاً عن الكثير من تجاوزات الخدام, الذين بدونهم لن تقوم لتلك الخدمة قائمة, فهذة مصيبة حقيقية واقعية تعيشها الإصلاحية بكل مرارة وبكل كتمان شديد, لئلا تجف البقرة الحلوب!!
وسبب ثانى لغرور الخدام, هو إختفاء روح إنكار الذات, لغياب روح الأباء والقدوة والمثال, ماذا تنتظر من ابن يحتقر تعاليم أباه؟ كيف سيتعلم وجوب تهذيب سلوكه, فى غياب المرشد والمصحح لأخطاءه؟!
وهناك موضة جديدة بهذا الخصوص فى البروتستانتية, تراها بوضوح مع د سامح موريس مثلاً, وغيره الكثير من قادة الإصلاح, يمجدون ويرفعون قيمة وقامة أباء الأرثوذكسية, دون ان يفهموا ما قاله هؤلاء الأباء فهماً حقيقياً صحيحاً, لترى فى نهاية الأمر عجباً, فالنتيجة النهائية لعظاتهم الموجهة للشعب دائماً, هى الضدّ المضاد لما قصده هؤلاء الأباء, الذى قد زُجَ بأسماءهم عنوة وإجحافاً, لمآرب أخرى غير القصد والهدف لهؤلاء الأباء أنفسهم!!
وان كانوا هؤلاء الخدام محبين للوحدة حقاً كما يرددون دائماً, لعرضوا الأمر اولاً, على أولى الأمر من المعاهد اللاهوتية الأرثوذكسية المختلفة, المتخصصين ببحث مثل هذة الأمور, لتحديد مدى إتفاقهم وإختلافهم مع أقوال الأباء الكبار, فيعلنون بأنهم قد اتفقوا مع المعهد الفلانى الأرثوذكسى, على بعض من اقوال الأباء الارثوذكسيين الكبار, أو اختلفوا جزئياً معه, لتصبح هذة خطوة محفزة للتقارب بين الطوائف, فيكون هذا الإعلان نبراساً لمن يريد ان يكون صادقاً وجاداً ومحباً لوحدة الجسد الواحد!
أما مجرد عرض أسماء أباء الأرثوذكس على عامة الشعب البسيط, بهذة الطريقة السطحية الملتوية, لهو شئ مشين لرأس الخادم أولاً, ولرأس الكل البروتستانتى ثانياً, فالتاريخ لن يرحم أحداً, ولن يطوى رياءً ولا كذباً, إلا ويفضحه!!
فنسأل …..
لماذا الزج بأسماء أبائنا الأرثوذكس, فى مقال ومقام يختلف تمام الإختلاف معهم, ومع حياتهم واقوالهم؟!
وهناك موضة جديدة بهذا الخصوص فى البروتستانتية, تراها بوضوح مع د سامح موريس مثلاً, وغيره الكثير من قادة الإصلاح, يمجدون ويرفعون قيمة وقامة أباء الأرثوذكسية, دون ان يفهموا ما قاله هؤلاء الأباء فهماً حقيقياً صحيحاً, لترى فى نهاية الأمر عجباً, فالنتيجة النهائية لعظاتهم الموجهة للشعب دائماً, هى الضدّ المضاد لما قصده هؤلاء الأباء, الذى قد زُجَ بأسماءهم عنوة وإجحافاً, لمآرب أخرى غير القصد والهدف لهؤلاء الأباء أنفسهم!!
تقصد مديحهم للآب متى المسكين يا سوستانيس؟
هو بيحبوه فعلا و بيقراوا له و حدث لى موقع مع فتاه غير أرثوذوكسية و لكنها خادمة محترمه جدا و مدحت فيه كثيرا و أن أوضحت لها أنى أنا شخصيا أحبه و لكن لا أقرا له كتبه الضخمة و هى ثرية جدا و ذلك لإرتفاع سعرها و أننا لدينا تحفظات عليه و للكن أنا لا أشكك فى قيمة هذا الرجل و طلبت منى كتابه عن الخدمة و أنا أهديته لها و قلتها عندى له عشرات الكتيبات و قرأتها فعلا
و مدحه سامح موريس و لكنى اجد أسلوبه هجومى عليناو على أبونا داود لمعى و الأساقفه
الأستاذ ديفيد
—————–
شكراً لك لإثارة نقاط فى غاية الأهمية فى موضوع الفارق بين التسبيح الأرثوذكسى والبروتستانتى, وهل هذا الفارق هو فارق فى محتوى التسبيح من كلمات ومعانى؟ وهل التسبيح يتوقف ويعتمد على الاختبار الشخصى للمرنم؟
وهذة النقاط الجوهرية تضع على عاتقنا مسؤلية تكميل البحث, ليتضح لنا كيف إن التسبيح الأرثوذكسى, يختلف تماماً عن الإنشاد البروتستانتى, كما أكد على ذلك د جورج, فالتسبيح الإرثوذكسى يفوق كل كلمات الترانيم ذاتها, حتى ولو أنشدوا بذات كلمات تسبيحتنا الأرثوذكسية القديمة !
لأن التسبيح الأرثوذكسى بالرغم من إستخدامه للكلمات, إلا إن أفاقه تفوق كل الكلمات والمعانى والتعبيرات !
ولنكرر الإجابة مرة أخرى ليكون واضحاً, بانه لا يمكن أن يكون الفارق بين التسبيح فى الأرثوذكسية والبروتستانتية, هو المحتوى من الكلمات, حتى ولو سُرِقت من ليتورجيتنا الاصيلة, ولبيان هذا, سنتابع سوياً المفاهيم المغلوطة المطروحة لخداع الشعب الأرثوذكسى, وهذا سيظهر جلياً فى مداخلاتنا القادمة, ما قد اصروا على إخفاءه من التاريخ, ومن إصرارهم على الترنم بإستخدام ذات كلمات تسبيحنا, حتى نصل لحقيقة التسبيح الأرثوذكسى, وحقيقة إختلافه الجذرى عن الإنشاد والغناء الدينى فى البروتستانتية.
أما عن سؤالك ممن من الأباء قصدنا فى تلك الفقرة المنتقاة بواسطتكم؟ قصدنا ابونا متى المسكين كقديس معاصر, وقصدنا أيضاً بقية أباء الأرثوذكسية الكبار, الذين يزج بأسماءهم عنوة, فى محاولة يائسة لإثبات صحة تاريخية لاهوت البروتستانتية, وكأن هؤلاء الأباء الأرثوذكس كانوا من جنود مارتن لوثر, او المصلح السويسرى هالدريش زوينجلى, مارتن بوتسر, جوليوم فاريل, جون كالفن, جون هس, جون ويكلف, لقد حاولت سرد بعضاً من المصلحين الذين خربوا بل حطموا الكنيسة فى الغرب, بدعوى ساذجة غبية أنانية مادية منهم لإصلاح الفساد !!
متغافلين عن إن الإصلاح الحقيقى للفساد هو الصلاة وليس الثورة, التى تحطم ولا تبنى, تقسم ولا تجمع !
فلتلاحظ أيضاً شيئاً غريباً يجمع كل هؤلاء المصلحجية! وهو إحتقارهم للتاريخ, فالأصلاح الخرابى هذا قد إستغرق وقتاً ليس بقليل, من القرن الرابع عشر حتى أوائل القرن السابع عشر, دون ان يلتفت أحد منهم للخراب والدمار والتفتيت والإنقسام الذى قد أحدثوه فى جسد كنيسة المسيح, الذى قصبة مرضوضة لا يرد, وفتيلة مدخنة لا يطفئ, ولا أحد يسمع صوته !
سنعود للمعالجة التاريخية مرة أخرى.
رجاء مراجعة المقالة الثالثة من هذا الموضوع للدكتور جورج فلقد شرح فيها ومضات من التاريخ المعاصر, تعين الإنسان الباحث على تتبع أعلانات الحق فى تاريخنا.
دكتور / جورج
حضرتك تخاطب الشعب المسيحي الذي يستمع للترانيم الروحية وكأنهم كلهم دارسين عقيدة ولاهوت ومؤمنين ومدركين تفاصيل ومعاني كل كلمة من كلمات الترنيمة ، وتغيب عن حضرتك ان كم كبير من هذا الشعب اطفال وشباب ومسيحين بالأسم وغير دارسين كتاب مقدس او عقيدة او لاهوت . باختصار معظهم شعب المسيحي بسيط غير دارس يريد الكلمة البسيطة التي يمكن ان يفهمها وهذا ما وجدناه في كلمات المرنم (ماهر فايز) بما تحمله من بساطة في المعني الذي يقصده الكتاب المقدس والذي يصل اللى كافة الشعب من متعلم وجاهل ومؤمن وغير مؤمن ودارس الكتاب ومسيحي بسيط غير دارس .. لو كل ترنيمة كتبت بقصد حضرتك من مفاهيم ودراسة لاهوتية ،كثير من الشعب لم يفهمها . يجب ان تخاطبوا الشعب المسيحي بتدريج تعاليمه ومفاهيمه
كلمات الترنيمة بما تحمله من مفاهيم بسيطة . ادت اللي ان طفلتي التي لا يتراوح عمرها الحاية عشر . تشرح لي ما تحمله الترنيمة من معاني حقيقية وصادقة كما شرحها لنا مسبقا كاتب الترنيمة .فا لو لم تكون هذه الكلمات بسيطة لما يحمله الكتاب المقدس من معاني ثامية لما كانت تصل لعامة المستميعن بمختلف اعمارهم وتعاليمهم وروحانياتهم .. لو كانت كل كلمات الترانيم تنطق بما تحمله من عقيدة وكلمات يصعب على المستمع البسيط فهمها . لا كان كل مستمعين الترانيم الروحية هم الدارسين فقط واللذين يسهل عليهم فهم هذه الكلمات .. سامحني . انا لا انقد بل لأوصل صورة المستمع البسيط او المستمع الغير دارس او متعمق بدراسة الكتاب المقدس الذي لا يدرك ان محبة الانسان في المصلوب كما ذكرت حضرتك لانه ببساطة ممكن يكون هذا انسان مسيحي بالأسم لم يعرف شئ عن المصلوب وكل معرفته بمحبة الانسان هو ( محبة الذات فقط ) . مفهوم كلمات* يا من تميتني عني* .. لأي مستمع اي كان عمره او مفهومه يعني تميتني عن ذاتي وشهواتي وتحيني فيك وحدك .. كما فهمت طفلتي وكأن الاخ ماهر مدرك كيف يوصل مفهوم موت الذات لأبسط العقول لتكون سهلة الفهم للكبار والصغار.. لذلك ترى الترانيم والمعاني القوية الفهم التي تقصدها حضرتك لا يسمعها غير فئة معينة من الشعب وليس عامة الشعب .المستمع الوحيد الدارس الذي يفهم .. هو المستمع الدارس او الملم بدراسة الكتاب المقدس وتفسيرة .. شكرا لحضرتك.. واترك الكلمات البسيطة المؤدية للمعني الصحيح للكتاب المقدس تخاطب الخاطئ ربما يوما يعود .. الابرار لا يحتاجون للمخاطبة وكم من ترانيم الاخ ماهر دعت خطاه كثيرين للتوبة بكلماته المجربة والمؤخوذة من الكتاب المقدس.. شكرا دكتور جورج..
فى مقابلة تليفزيونية للمرنم ماهر فايز على قناة المحور فى عام2010 كان معه فى اللقاء كلا من الشيخ الهلباوى و المنشد على الهلباوى
فى اللقاء عبر ماهر فايز عن اعتقاده بأنه يمكن ان يشارك الشيخ الهلباوى و ابنه على فى التسبيح و الترنيم مادامت ل (الله) و ان الترنيم او الانشاد لا يختلفا فى كونهما تجربة شخصية صيغت باسلوب شعرى جميل و لكن السيد ماهر فايز يوضح ان دور المرنم و المنشد هو نقل الانسان المستمع او المشارك له فى الترنيم الى الحالة الروحية الاختبارية التى خاضها هو قبلا؟؟؟؟؟؟
عندما يصبح الاختبار الشخصى المصاغ فى شكل ترنيمة الى وسيلة للاطلال على يسوع او النظر الى وجه الرب (و انا لست ضد هذا بالمناسبة ان اخذ فى اتجاه تعليمى صحيح يوضح السلوك الروحى او التدريب و الجهاد الذى خاضه الشخص للوصول الى ما وصل)
بل عندما تصبح هذه الترنيمة مصدرا للعقيدة او التفسير
فههنا الخلل
الخلل الذى اصاب كل شئ
لا اذكر بالضبط اين قرات هذا المعنى(ان رايت الاخ يمشى على النار او يطير فى الهواء او يقيم الموتى فلا تهرع وراءه قبل ان تسال ما عقيدته و باى شئ يؤمن و كيف يؤمن)