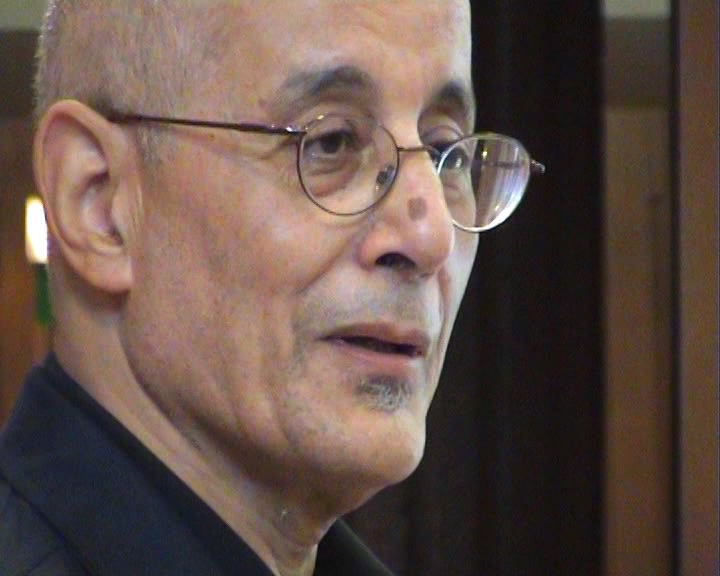 إذا كان سوء استخدام العقائد الدينية قد أوحى لبعض الشباب والشابات بالبحث عن الإلحاد كطريق للخلاص من السيطرة القهرية على الفكر وعلى الحياة، سيطرة لها منهج وسلطة عليا تضع الله أو نصوصاً مقدسةً لقهر واستعباد الإنسان، ففي تقديري أن الإلحاد ليس هو التحدي الحقيقي لسوء استخدام الإيمان، بل هو أضعف أنواع التحدي. فقد سمعت من أحد أبطال حرب أكتوبر 1973 أن رماية مدافع القوات المسلحة على نقط حصينة في خط بارليف لم تكن تؤثر مطلقاً، وكان من الضروري تفجير هذه النقاط الحصينة من الداخل. والعلوم العسكرية منذ أرسطو هي تطبيق لما عرفه الإنسان من المنطق، فقد طبَّق الإسكندر الأكبر بعض نظريات أرسطو في الهندسة على توزيع المشاة …
إذا كان سوء استخدام العقائد الدينية قد أوحى لبعض الشباب والشابات بالبحث عن الإلحاد كطريق للخلاص من السيطرة القهرية على الفكر وعلى الحياة، سيطرة لها منهج وسلطة عليا تضع الله أو نصوصاً مقدسةً لقهر واستعباد الإنسان، ففي تقديري أن الإلحاد ليس هو التحدي الحقيقي لسوء استخدام الإيمان، بل هو أضعف أنواع التحدي. فقد سمعت من أحد أبطال حرب أكتوبر 1973 أن رماية مدافع القوات المسلحة على نقط حصينة في خط بارليف لم تكن تؤثر مطلقاً، وكان من الضروري تفجير هذه النقاط الحصينة من الداخل. والعلوم العسكرية منذ أرسطو هي تطبيق لما عرفه الإنسان من المنطق، فقد طبَّق الإسكندر الأكبر بعض نظريات أرسطو في الهندسة على توزيع المشاة …
لذلك أقول إنه لا بُد من هجوم يقود حركة إصلاح من داخل التراث الديني، وقد رفع علماء الأزهر عَلَم “الوسطية”، وهو ذات الاتجاه الذي عَلَّم به بعض آباء النسك، والذي تلخصه العبارة المشهورة: “الطريق الوسطى (المعتدل) تخلِّص كثيرين”.
ومن داخل تراثنا الديني المصري –كما أشار واحد من دعاة الإلحاد- أنه لم يقرأ ما يستحق التقدير سوى كتاب تجسد الكلمة للقديس أثناسيوس الرسولي. هذه لمسة حق نابعة من قلب أدرك أن العقائد ليست “غيبية”، تشير إلى ما وراء الطبيعة، بل عقيدة المسيحية الأولى هي تجسد ابن الله، والتجسد هو استعلان الله نفسه في “لحم ودم الإنسان”. فقد صار الإنسان نفسه هو كتاب الاستعلان الإلهي، أي أن هذا الاستعلان لم يعد حروفاً وكلمات، بل التعبير الحقيقي الإنساني الذي يعلو على كل اللغات، وصار فهم الإنسان لحياته وكيانه كإنسان هو أول فصل من فصول الإيمان.
كان الأب فليمون المقاري -الذي لم يدرس الفلسفة أو اللاهوت- يقول لنا: “قبل أن تؤمن بالله يجب أن تؤمن بنفسك”. ولمَّا سُئل عن معنى هذه الكلمات –وكان كلامه دائماً موجزاً- قال: “إن الإيمان يبدأ بمعرفة الإنسان لنفسه كإنسان. ما هو؟ وماذا يريد أن يكون؟ لأن هذه هي أساسات الحياة الحقيقية” (هكذا نقلت كلماته).
وكان ملخص الحكمة القديمة على معبد دلفي في اليونان هو “اعرف نفسك”، وهو ملخصٌ لما ورد أيضاً في سفري الأمثال والجامعة، وفي حكمة سليمان، وحكمة بن سيراخ. ولكن –بكل أسفٍ- غاب تدريس الحكمة من التعليم المعاصر، وكان ذلك هو أساس التعليم حتى في العصر الوسيط، وهو يعود إلى أكليمنضس وأوريجينوس، هذا إذا استطاع الباحثون عن الحكمة الابتعاد عن الدراسات اللغوية واكتشاف الأهداف الحقيقية للتدبير والثيؤلوجيا (راجع كتابنا: المدخل إلى اللاهوت الأرثوذكسي).
لقد جاء التجسد بحقيقة واحدة، وهي بحث الله نفسه عن الإنسان، ودخوله دنيا الإنسان، ليس بخطابٍ، بل بحياة إنسانية. ولذلك، الأناجيل، وهي حياة يسوع ابن الله المتجسد، تراه إنساناً. تعثر في ذلك الأريوسيون، وتبعهم شهود يهوه. ولذلك، الظن بأنه مجرد إنسان وليس إلهاً، يعيد التعليم إلى المربع الأول: مربع الخطاب. ودور الكلمات ومدارس تفسير الكلمات، هي حركة مضادة تماماً لتجسد الكلمة. والفرق الكبير بين الأسفار عند الآباء، والشرح المعاصر عند عظماء الأكاديميين، هو أن الآباء شبعوا من التدبير وأعلنوا سر المسيح، وهو ما غاب من مؤلفات معاصرة لعلماء كبار في أكبر معاهد اللاهوت. والشبع من التدبير عند الآباء هو:
* شرح سر المسيح الإله المتجسد.
* شرح حقيقة وأبعاد الشركة الإلهية – الإنسانية التي جاء بها المتجسد. ولكي ندرك أننا لسنا إزاء مسائل غيبية، فإن أصدق وأسهل تعبير هو:
“الكلمة صار جسداً” (يو 1: 14).
والشرح لِما يعيشه الذي يقترب من إنسانية الكلمة المتجسد، هو:
“فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً وأنتم مملوءون فيه” (كولوسي 2: 8).
لقد جاء المسيح لكي يعلن لنا إنسانية الإنسان الضائعة، أي الإنسان الذي يحيا لنفسه فقط، فيخسر حياته. وأيضاً الإنسان الذي يتمسك بتقاليد القهر وسيطرة شريعة على الحياة، فقال: “قد سمعتم أنه قيل للقدماء …”، ثم أضاف: “أما أنا فأقول لكم …”، ولم يكن ذلك إلَّا تحرير الإنسان من تراثٍ دينيٍّ قديم استعبد الإنسان إلى الحرف.
تأمل هذه المفارقة: في وسط اليهود، يقدِّم الرب يسوع مثَل السامري الصالح، بينما السامري عند اليهود نجسٌ لا يحفظ الشريعة. ولكنه –السامري- هو الصالح الذي فعل الصلاح مع ضحية اللصوص الذين هاجموه في طريقه إلى أريحا، ولم يذكر يسوع شيئاً عن دين أو جنس الجريح. ولا بُد أن المثَل أصاب اليهود بالخيبة والغيظ معاً؛ لأن “المسيا”، أي المسيح يهدم تراثهم الديني؛ لأن اللاوي والكاهن لم يقدم كلاهما المساعدة للإنسان الجريح؛ لأن “لمس دم الإنسان هو نجاسة”، تمنع من الصلاة.
هذا ليس تعليماً “غيبياً”، بل تعليم إنساني يمس المجتمع المنقسم إلى فئات يحكمها تراثٌ قديم.
وثمة مسألة أخرى ذات دلالة، فقد مات يسوع مصلوباً، ولكن المصلوب دخل عالم ما وراء الطبيعة، عالم الغيبيات -من وجهة نظر- الذين قالوا إنه دفعَ ثمن خطايا البشر، فأخرجوا بذلك المصلوب من الواقع، ومن الحياة، ومن الليتورجية نفسها. أخرجوه من الواقع؛ لأن كل صاحب دعوة حق غالباً يُصلَب. وأخرجوه من الحياة ؛ لأن الحياة لا تتقدم إلَّا بالمصلوبين من أجل خير وحرية الشعوب. وأخرجوه من الليتورجية لأن الليتورجية هي خدمة يسوع لنا عندما يدخل كذبيحة وقربان يقدِّم الحياة لكل خطاة الأرض، بينما دفع ثمن الخطايا يلغي كل ما تقدَّم، ويحول الصليب والمصلوب إلى فكرة في ورقة أو مقالة على رفِّ مكتبةٍ وليس في الواقع الحي الذي تحياه الجماعة، أو الشخص الذي يؤمن بأن تقديم الحياة هو طريق التقدم، وأن المعاناة هي إحدى وسائل الحرية التي لا يمكن للحرية أن تعبِّر عن نفسها إلَّا بالمعاناة؛ لأن الحرية تغسل القهر والاستبداد. والذين يملكون سلطةً اخترعوها لأنفسهم ورضي بها العبيد، هؤلاء هم قتلة يسوع، وكل يسوع عندنا هو كل صاحب دعوة للحرية.
وثمة مسألة أكبر؛ لأن التصدي لقضية المصلوب سهلةً، ولكن الانغماس الكياني في الثالوث الآب والابن والروح القدس، هو التحدّي الحقيقي الذي حاول البعض الالتفاف عليه، فقالوا إن الثالوث هو صفات ذاتية جوهرية، فتحول الثالوث -عندهم- من استعلانات شخصية لأقانيم حية عاملة باذلة ومُحبة إلى صفات صامتة قابعة في جوف تلافيف الفكر. أمَّا الثالوث، فهو تحول الإنسانية، هو شركة في محبة الله. ودعوة لاكتشاف هذه الشركة ليس بالكلام أو اللفظ، بل بتغيير الحياة (وسوف نعود إلى هذه النقطة بالذات في مقال خاص)؛ لأن الثالوث -حسب تعبير الأب فليمون المقاري- هو “معاملة”، وكان ذلك تعليقاً على عبارة “الدين المعاملة”، فقال: “الثالوث وحده هو المعاملة الصَّح، (أو الحق)؛ لأننا لا يمكن أن نزيِّف المحبة … “. تلك كانت عبارة سمعتها منه في عام 1958 أكَّدتها رحلة البحث الطويلة عن كتابات الآباء، حيث قادتني تلك الرحلة إلى ما سجَّله الآباء باليونانية والقبطية والعربية واللاتينية: أثناسيوس – كيرلس – هيلاريون – أوغسطينوس – صفرونيوس – غريغوريوس أسقف قبرص (ق 12) – ريكاردوس الفيكتوريني … ثم المؤلفات النسكية في مصر واليونان، وغيرها.
الثالوث هو انغماس الإنسان في المحبة الإلهية؛ لأن المحبة تجيء من مصدرها، وهو الآب، ومن إعلان بنوة يسوع، ومن عطية الروح القدس، تقابل الصدر والقلب في الإنسان، وحاجة الإنسان لأن يُحَب ويُحِب ويتحد أو يشترك، أي الحركة الثلاثية للمحبة. فإذا كان القلب هو مصدر المحبة في الإنسان، فإن العقل الباحث دائماً هو الذي يقبل الاستعلان، ولكن تبقى الروح أو النفس عارية تماماً بدون الاتحاد؛ لأن الروح هي أساس الاتحاد، وهي مجال قبول عطية الروح القدس.
هكذا خُلِقَ الإنسان بحركة ذاتية ثالوثية:
يُحِب to love
يُحَب to be loved
يتحد to be limited
وعندما قلنا إن الزواج هو ذات الحركة الطبيعية، ثار علينا واحدٌ من الخصيان([1]) لم يتذوق المحبة، ولا عرف كيف يلد أولاداً للآب السماوي؛ لأن أحد أقدم شرح ليتورجي هو للقديس أكليمنضس: “إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أكون أنا في وسطهم”، فقال: “إن الاثنين هما الزوج والزوجة، والثالث هم الأولاد”.
في عيد تجسد ابن الله، يدعونا التجسد إلى:
أولاً: أن نقبل to receive إنسانيتنا كما هي، لكي نكتشف كيف يمكن أن نصبح أفضل، ليس بالتقدم الأخلاقي؛ لأن المسيح لم يؤسس مدرسةً سلوكية أخلاقية، بل جاء بهبة حياة لتجديد الكيان.
ثانياً: أن نعيد التفكير في أسلوب حياتنا لأن جذور الوجود الإنساني هو في ثالوثية المحبة التي أشرنا إليها: ما نحِب، وكيف نحِب، وغاية المحبة، وهي الاتحاد. فقد جاء يسوع بالمحبة الأعظم، ومكانها قلب الإنسان، وجاء بعطية أكبر من قلب الإنسان، وهي عطية الروح القدس، روح المحبة (رو 5: 5)، وجاء أيضاً بالاتحاد بالله كطريق لتقدم إنسانيتنا، وُصِفَ قديماً باسم Metamorphosis وهو الاسم الذي يصف تحول الدودة إلى فراشة،، وهو ما يعبِّر عن تحول الإنسان جسداً ونفساً إلى صورة جديدة هي “التجلي” (راجع النص اليوناني لمرقس 9: 2)، وعن الإنسان (رو 12: 2)، وهي صورة يسوع الذي بدأ طفلاً ينمو مثل باقي البشر، ولكن ليس النمو بالإرادة الذاتية التي تبع من الذات وإلى الذات، وهي إرادة آدم الأول، بل الإرادة التي بالاتحاد بلاهوت الابن الكلمة لأن الإرادة الذاتية من الذات وإلى الذات المنغلقة هي أفضل ترجمة Gnomic Will وهي الحركة الطبيعية للإنسان الساقط بلا شركة الذي يسعى نحو ذاته، والتي قال عنها معلم الحياة إن شرط التلمذة هو جحد الذات وحمل الصليب والسير مع يسوع. وجحد الذات، أي الميول التي تحركها الإرادة المستقلة “من طلب ذاته يهلكها”، هكذا قال يسوع، ولكن “من جاد بذاته يجدها”، أي وجدها تنمو نحو ما هو أعظم في الإنسان، وهي مسيرة التجديد الكياني.
دكتور
جورج حبيب بباوي
يناير 2014
([1]) هكذا وصف القديس أثناسيوس أريوس بأنه لا يعرف إلَّا الخصيان Eunucn. “كان الخصيان Eunuchs في قصر الامبراطور قسطنطين هم الذين دبروا المكيدة ضدنا، ومن المدهش حقاً ذلك الاتفاق الغريب أن الهرطقة الأريوسية التي تنكر ابن الله قد أخذت تأييدها من الخصيان الذين بلا خصوبة في أجسادهم ونفوسهم عارية بلا فضائل Both their bodies are Fruitless and their Souls barren of Virtue هؤلاء لا يحتملون أن يسمعوا كلمة ابن .. بل يحولون وجوههم بعيداً عندما يسمعون كلمة الآب أعلن الابن، وبجنون يقاومة بشراسة كل من يقول إن ابن الله هو ابن الله الحقيقي. هذه هي هرطقة الخصيان أنهم لا يؤمنون بالابن الحقيقي المولود من الآب. وعلى هذا الأساس فإن القانون يمنع هؤلاء الأشخاص أن يكونوا في مجمع كنسي” (راجع تاريخ الأريوسية للقديس أثناسيوس الرسولي، فقرة 38، الترجمة الإنجليزية ص 283).


