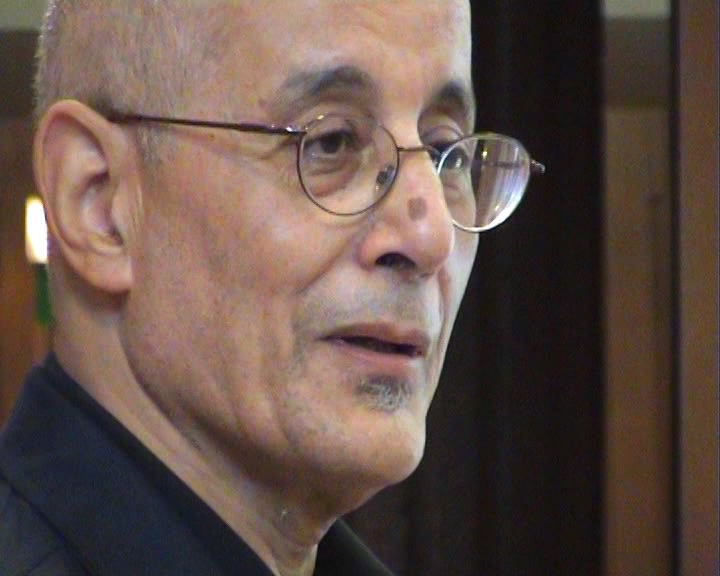 صلاةٌ مرفوعةٌ على مذبحِ تدبيرِ خلاصنا
صلاةٌ مرفوعةٌ على مذبحِ تدبيرِ خلاصنا
-1-
نداءٌ للمخلِّص ربنا يسوع
حاولتُ يا مخلصي أن أكتب شعراً، لكن القوافي تُضيعُ المعاني وتطمسُ الحقائقَ. وقد تحوَّل سِرُّ وجودِكَ فينا إلى فكرةٍ في عقولنا.
أنت الحياةُ، فيضُ محبةٍ وصلاح. قال عنه رسولُك: “إننا نأخذ من ملئه، نعمة فوق نعمة”. أنت كشخص (أقنوم) لا تتكاثر، فليس فيك نقصُ البَشَرِ الذي يدعونا إلى خلق “امتداداتٍ” Extensions للذات. الذاتُ التي تسعى “للتعدد” Multiplications هي ذاتٌ ضربَها الموتُ فصارت تلتمس “تعدُّدَ الوجود”.
أنت تعطي حياتك لكي “نصير مثلَكَ” (1يوحنا 3 : 1-2)، وتظل أنت “الرأس”، أو الأصل، أو البداية. بدايةُ ملء الحياة. تعطي من كيانك لنبقى أعضاءً في جسدك (1كو 12)، لا لكي يصبح كلٌّ مِنَّا “رأساً” مطابقاً لك. لو حدث هذا المستحيل، وتحوَّل كلٌّ منا إلى رأسٍ مثلِكَ، لَصِرنا بلا شركة، بلا نعمة.
مع أن رسولَكَ قال إن اليدَ والأُذن والعين في الجسد الواحد تبقى كما هي عضواً متمايزاً، ولكن الحياة، حياة الجسد واحدة، إلَّا أن صراخَ الرعاعِ مزعجٌ، فاحفظنا يا ربُّ.
لقد جاء تجسُّدُكَ بالتمايُز بين الأشخاص، فقدناه ودمرناه. بالشَّرِّ الذي فينا نريد أن نزيل التمايز لكي تمتد السلطة Authority وعندما تسود السلطة تختفي المحبة، ومع اختفاء المحبة تختفي الشركة وتضيع النعمة.
بالرغم من أنني لن أتحول وأصبح “يسوع”، ولكن في تمايُزي Distention يصبح خلودُ يسوع هو خلودي، وميراثُ يسوع أي الملكوت، هو ميراثي، وشركة يسوع في الآب هي شركتي، ومسحة يسوع بالروح، هي مسحتي، ولذلك قال رسولك: إن “الروح القدس” هو روح يسوع؛ لأنه فيك ومنك ومعك واحداً.
صراخُ الأغبياءِ يضايقني. يريدون أن أعود إلى آدم الأول، ويحاولون أن يطمسوا جلال مجدك! هل لك نوعين من المجد؟ لو كان لك يا يسوع نوعان من المجد، مجدٌ إلهي ومجدٌ مخلوق، فكيف يظل المجد المخلوق مجداً؟ كل ما خلق من العدم ليس فيه خلود أو بقاء أبدي.
-2-
قُوَّتُكَ يا مخلِّصي
سوف أُصبح مثلك ابناً، حيَّاً إلى الأبد، قائماً بالجسد في قيامةٍ أنت صانعُها وواهبها. لو حاولتُ أن أكون غيرك، لَفقدت الخلود. ولو حاولتُ الخلود بقوتي الذاتية، لَسقطت في العدم. ولو حاولتُ الخلود، أي مجرد المحاولة، لَفصلتُ نفسي عنك. قوتُكَ يا مخلصي هي كيانك، وأقنومك المتجسد مستعلَنٌ لكي يجدد المائتين. ولو انفصلت القوة عن أُقنومِك وأخذنا نحن ما هو منفصلٌ عنكَ، لَسقطنا في الموت؛ لأن الموتَ اغترابٌ عنكَ، وابتعادٌ عن الشركة. هروبٌ من المحبة الفيَّاضة إلى كياننا الهزيل الذي هو صورة، وليس واجبَ الوجودِ.
-3-
شركتُكَ يا ربِّي في الآب، وفي الروح القدس
هل سيدوس الجُهَّالُ على نعمتِكَ؛ لأنهم لم يشربوا من مياه الإنجيل، بل شربوا المياه الآسنةَ القاتلةَ للحياة؟ يقولون: لن نتساوى بكَ. وهل قال أحدٌ إنه مساوٍ لكَ، أو للآب أو للروح القدس، إلَّا نزلاءُ مصحَّاتِ الأمراض العقلية؟ هؤلاء بالرُّعبِ، يخلقون حفرةَ للبسطاءِ لكي يُنسوهم، أو يخيفونهم من بركة الإنجيل.
مَن ذا الذي يمكنُهُ حتى فهم شركة الأقانيم؟ ومَن ذا الذي يستطيع أن يقول إنه مساوٍ لكَ في الأزلية؟
لقد خُدعنا عندما أنكرنا جنون أوطاخي، دون أن نفتِّشَ عليه فيما تفشَّى عندنا من نُسكٍ مزيَّفٍ، ألغى إنسانيتكَ، وحصر حياتك في الألوهة فقط.
للأسف، مازال أوطاخي يحيا بيننا يا يسوع. مازال يعلِّم بنهاية إنسانيتك بعد صعودك المجيد. كأن تجسُّدَكَ قد أدَّى ما عليه من دور، ولم يكن اتحادَ محبةٍ أبديةٍ.
حاربنا شبحاً اسمه خلقيدونية (451). كأن الكلامَ عن طبيعتين في الأقنوم الواحد جريمةٌ نكراء وهرطقة .. بذلك هربنا من استعلان تجسدك.
ما أُعلن يا ربي في تجسُّدِكَ هو لنا -حسب اعتراف الآباء: “هذا الذي لأجلنا نحن البشر”. نزولُكَ إلى حقارتنا وإلى فقرنا لم يكن عن احتياجٍ لك، ولا لكي تقدِّمُ فديةً لآبٍ غاضبٍ، أو لكي تدفعَ ثمنَ خطايا. هذه الأراجيفُ حَذَفَت من وعيِّ الجُهَّالِ ما حوَّلته في كيانك المتجسد، أي إنسانيتنا التي أخذتَها من الأُم البتول عروسِ الحياة الجديدة مريم.
لكنك يا يسوع “لأجلنا جئت”، ولأجلنا حوَّلتَ الإنسانيةَ التي أخذتَها من والدة الإله. ولأجلنا جعلتَ هذه الإنسانية مُتَّحِدَةً بلاهوتِكَ، وبالآب وبالروح القدس؛ فغرستنا من جديد في جوهر الأُلوهة؛ لكي تتحول إنسانيتنا وتصبح مثل إنسانيتك.
لم يتحول لاهوتُك إلى إنسانيةٍ، بل تحوَّلت إنسانيتُكَ الواحدةُ معكَ وبكَ وفيكَ، الحيَّةُ بالاتحاد الأقنومي إلى حياتِكَ الإلهية الخالدة التي بلا فساد، تلك التي تقدِّمُها للآب ليس بديلاً، بل بدايةً لكي يقبلها الآبُ فيكَ، ويجعلها فيكَ وبكَ وبالروح القدس “الإنسانيةَ الجديدة”.
+ أصلُها Origin الأُلوهة، وليس آدم.
+ مصيرُها Destiny ليس فقط القيامة لعدم فساد، بل ميراث الملكوت.
+ صارت في المسيح تنالُ ميراثَكَ أنت (رو 8 : 17)، أي ميراثِ الابن المتجسد، لا ميراثَ العبد الذي لا ميراث له؛ لأن أحكام الشريعة لا تعطي ميراثاً أبدياً.
أخذتَ الذي لنا لكي يصير ما هو لكَ، لنا نحن:
من صلوات الأُم، أُمِّ الشهداء أخذتُ هذه الكلمات، وأضفتُ إليها كلماتي من أجل ضِعاف العقول والخائفين من النعمة: أخذ الذي لنا، أي الإنسانية. أعطانا الذي له، أي حياته، وجسده ودمه، وميراثه الأبدي وقيامته المجيدة، والدخول إلى السماء، والجلوس عن يمين الآب.
أودُّ لو نشرتُ أناشيد أسد كبادوكية، النزينزي الذي غَطَسَ بكامله في بحر محبتك، ونالَ من ملء النعمة، ولكن لذلك الأسد زئيراً سوف يرعب الخائفين من النعمة:
+ الآبُ لا يخاطبنا كعبيدٍ؛ لأنه لا ينكر بنوتنا في الابن الذي أرسله.
+ خطابُه ليس خطاباً بلفظٍ، بل “حوارُ الشركة”، أي انطباق اللفظ على الواقع، وعلى الكيان نفسه. الكلمةُ عندنا لفظٌ، أمَّا الكلمةُ عندكَ فهي استعلان الإرادة، وهي إظهار “السِّرِّ”، واستعلانُ المحبةِ الفيَّاضةِ التي تُوهَب لنا.
-4-
الجسدُ المُحيي، جسدُكَ يا سيِّدُ حياتي
بصوتك الإلهي الذي لا غشَّ فيه: “الجسدُ لا يُفيد شيئاً”، وبدون اتحاد جسدك بلاهوتك، لا يفيدنا الجسدُ شيئاً. لكنه -بالاتحاد- صار “الجسد المحيي”.
زئيرُ كيرلس الكبير يخيف الغارقين في محبة أجسادهم.
لكن، وقد جاء صومُك الأربعيني يا سيد كل الصائمين، أصومُ لكي يتحرر جسدي من ذلك الوجود المزيَّف، ذلك الوجود الذي فَرَضَته الخطيةُ والموتُ، حيث تحصَّن العقلُ في خلودٍ ذاتيٍّ نابعٍ من كياني، وبذلك يعود الخلودُ المزيَّفُ إلى كياني.
أتحوَّلُ بالشركةِ في جسدِكَ إلى ذاتِ التحوُّلِ الذي حَدَثَ لجسدك. لكنك أنت الرأسُ الواهبُ الحياةَ، وأنا العضوُ القابلُ الحياةَ، ولذلك يتعذَّرُ عليَّ أن يكون جسدي واهبَ الحياة.
من أجساد الشهداء، بل وبعض النُّسَّاكِ، عادت الحياةُ -حقاً- لمن طلبها، ولكنها لم تكن حياةً ذاتيةً للقديسين والشهداء، بل حياتُكَ أنت التي تملأ كلَّ عضوٍ في جسدك بالحياة.
تألَّه جسدُكَ لكي يتألَّهَ جسدُنا، والأُلوهة هي عدمُ الفساد والخلود ومجد البنوة.
هل تعيش -يا سيدُ حياتي- في السماء، حياةً جسدانيةً؟ أم أنك صرتَ -بالقيامة وصعودك- في المجد الإلهي، تحيا حياتك الإلهية، تلك التي طلبتُها ليلة آلامك: “مجِّدني أيها الآب بالمجد الذي كان لي عندك قبل خلق العالم” (يوحنا 17 : 3 – 4)؟
لقد نزلتَ إلى صورة العبد، وأخذتها طواعيةً. هي صورتي أنا، الصورة القديمة، صورة الخلود الذاتي المستمدة من أحاسيس الجسد الطبيعي غير المُفتَدى بعدُ (رو 8: 23)، لكن جسدَكَ المحيي يعطي لحياتي، ليس “امتداداً” لِمَا هو طبيعي، بل لتألُّه ما هو طبيعي، إلى باكورة الحياة الجديدة الناهضة من الموت البيولوجي.
لولا الاتحاد الأقنومي، لولا القيامة والصعود، لولا تألُّه إنسانيتك .. لَتَوَقَّفَ العطاءُ، وصارت قُدَّاساتُنا أسخفَ احتفالٍ عندنا؛ لأننا -بدون الجسد المحيي- نبقى في حدود ما هو طبيعي. لكنك، فتحتَ تلك الحدود بالتجسد والصلب والقيامة. دحرتَ الموتَ والفساد، وصارت الإفخارستيا هي جسدَكَ المُمجَّد الواهب الحياة. وتألَّق الاتحادُ بك -يا ربُّ الحياةٍ- بوحدةٍ إلهيةٍ/جسدانيةٍ في الوليمة السمائية.
تلك الوليمة السمائية هي حسب اعترافنا الأرثوذكسي: “الذبيحة الإلهية – السمائية – غير المائتة”، هي جسدُ القيامةِ – جسدُ مجدِكَ (فيلبي 3: 21).
لكن تلاميذَ موسى يسألون عمَّا تبقَّى من الجسد بين الأسنان! هكذا، بالفتاوى، جعلوكَ تحت سيطرةِ الموتِ، وتحت سيادةِ الفساد، كيفَ، وأنت غالبُ الفساد؟
عَجَزَ القبرُ عن أن يحتويك. فعندما نشبَ سلطانُ الموتِ أظلافه في جسدكَ، تقصَّفَت، وانحدرت قوته. ومع ذلك، حوَّلَكَ فقهاءُ موسى إلى جسدٍ فاسدٍ، مائتٍ مثل أجسادنا، وكأنك لم تقُم من بين الأموات، رغم أننا نصرخ في كلِّ قداسٍ -بكل ما أُوتينا من قوة- قائلين: “وبقيامتك المقدسة، … نعترف”!
-5-
بكراً بين أخوةٍ كثيرين
أنت الأولُ، والبداءةُ الجديدةُ، ورأسُ الخليقةِ الجديدةِ. ومنكَ يا بِكرُ الخليقةِ نتحولُ إلى “تلك الصورة عينها من مجدٍ إلى مجدٍ” (2كو 3 : 18).
أنت آدمُ الأخير، وأنا أتحوَّلُ بكَ، وبالاتحاد بك أصيرُ مثلَكَ.
صراخُ الجُهَّالِ يُخيفُ الذين لا إيمان لهم. الذين يعرفون يسوعَ في حدود احتياجاتهم. أمَّا تلك العطية الكبرى: أن تصبح الأخَ البِكر – قال عنها أحد شيوخ الأسقيط منذ عدة سنوات: صلِّ وقل: “يا ربي يسوع المسيح، أنا أخوك أَعنِّي”. وعندما عبَّرتُ عن دهشتي، قال بوداعةٍ وحزنٍ: هل تؤمن يا أخ بالتجسُّد؟
لقد صار تجسُّدُكَ -وهو ركن التدبير الأول- المرجعَ لكل ما أعرفه. صارت صلاتي ليس لمن هو بعيدٌ، بل لمن هو أساسُ حياتي.
تحوَّل جسدُكَ إلى عدم الموت وعدم الألم -كما تسلَّمنا من العظيم أثناسيوس الرسولي حقاً- لأنك كنت تحوِّلُنا نحن فيك.
لا تحوُّل خارج كيانك، أي أُقنومك المتجسِّد.
خَلِّص يا ربُّ أُمَّ الشهداءِ من كلِّ تعليمٍ مزوَّرٍ يُقال من على منابرنا.
نحن نتحول فيك، أي إنسانيتنا، لا لكي نصبح نسخةً منك، بل لكي تبقى حياتُكَ مثل نارٍ تسري في حديدٍ باردٍ؛ فيتألَّقُ بنورها. وأنت أيها الذبيحُ الأعظمُ تتألَّقُ فينا وبنا أيضاً؛ لأنك تأخذ من كيانِكَ وتعطينا: معرفةَ الآب، شركةَ الروح القدس، بنوةً لا يمكن أن يغلبها الموت، ولا تقوى عليها الخطية.
أخوةٌ، وكثيرون
نحن لسنا إخوةَ اللاهوت. هي عبارةُ نسطور. بل إخوة الناسوت، وهي أيضاً مرفوضةٌ؛ لأنها تُقسِّم المسيحَ الواحد. والتقسيم والفصل هو منهج النسطورية، وهو المنهج الذي استخدمه أسقفٌ في تقسيم وفصل القوة والنعمة عن الأقانيم.
نحن إخوةُ “البِكرِ”.
والبِكرُ ليس الإلهَ وحده، ولا الإنسانَ وحده، بل الإلهُ المتجسِّدُ. فلا بكوريةَ للربِّ بدون تجسُّدِه. ولا بكوريةَ للجسد بدون اللاهوت. حسبُ التدبيرِ، قام الربُّ من الأموات، فصار “بكرَ الراقدين”. أولُ مَن قام، وبداءةُ القيامةِ؛ لأنه هو “القيامةُ”، وهو “الحياةُ”. بكوريةُ الربِّ هي أنه آدمُ الجديد أو الثاني أو الأخير.
كيف صرنا إخوةً للربِّ؟
بدون تجسُّدِهِ، هذا مستحيلٌ. وبتجسُّدِهِ وحده، بدون اللاهوت، لا إخوَّةَ لنا؛ لأن الجسدَ بدون اللاهوت، هو جسدُ إنسانٍ مثلنا. الذين لم يدرسوا المقالات الخمس ضد نسطور لم يسمعوا صراخ السكندري عن “الرب الواحد”، وهي عبارة مجمع نيقية 325م: “نؤمن بربٍّ واحدٍ”. هو بعد تجسُّدِهِ الربُّ الواحدُ الذي لا يمكن تقسيمه إلى اثنين.
قوةُ حياة الإله هي التي تجعل وحدتنا في “إخوَّةٍ” مصدرُها الحياةُ الجديدةُ التي لا فسادَ فيها ولا موت ولا دينونة.
لازال نسطور يعيش بيننا يا يسوع، بل ويرتدي ملابس الخدمة الإلهية. ولأنه نسطور، فهو لا يُدركُ أنه عندما يغطي يديه باللفافتين، إنما هو يؤكد أن الأيد الخفيةَ التي تقدِّسُ، هي يديك أنت يا ملِكَ الحياة.
لا يفهم هذا النسطور يا يسوع أن الجسدَ المحيي، هو جسدُ الحيِّ، وأن هذه الحياة هي حياةٌ إلهيةٌ، وأن هذه الحياة هي حياةُ المتجسِّدِ الذي حوَّل جَسَدَه إلى مجدِ الألوهةِ، وإلى مجدٍ سمائيٍّ؛ ذلك ميراثُنا الذي نأخذُ في السِّرِّ المجيد، ناهضين من أوجاعِ الموتِ والفساد.
-6-
الآبُ قدَّم ابنه لنا
دَخَلَت خرافاتُ العصر الوسيط في قلب التعليم. جاءت من لاهوت الكنيسة الإنجيلية. نقلها أسقفٌ جلس على كرسي ما مرقس الرسول، ولا زال يدافع عنها أسقفٌ آخر. لكننا نُقدِّم لك الشكرَ على ما لدينا من حقائق تاريخية وكتابية وآبائية:
أولاً: لا يوجد نصٌّ واحدٌ في العهدين يقول إن الابن دَفَعَ ثمنَ خطايانا. وسوء فهم كلمة “فدية” راجعٌ إلى الجهل بأصول الكلمة.
ثانياً: لا يوجد نصٌّ واحدٌ، ولا فقرةٌ واحدةٌ، بل ولا حتى أشعياء 53-54 عن العبد المتألم، تقول إن الآبَ غاضبٌ على الابن. وحتى صراخ الجُهَّال بأن “الربَّ سُرَّ بأن يسحقه بالحزن”، لا من أجل الانتقام، ودفع ثمن خطايا، أو لكي يصُّبَّ عليه غضبَه، بل لأنه جاء ووجد الآبُ مسرةً في تحرير الأسرى وعبيد الموت بحزن الابن. فأيُّ حزنٍ حزنه الربُّ في بستان جثيماني: “بدأ يحزن ويكتئب”، وقال: “نفسي حزينةٌ جداً حتى الموت”. حَزَنَ على الخيانةِ، وعلى بطرس، وعلى أوجاع الموت الغريبة على طبع مَن هو “الحياة”، ولكنه قام حيَّاً، ولم يكن للموتِ قدرةٌ على أن يُمسكَ به، هكذا صرخ بطرس يوم انسكاب الروح القدس الرب المحيي: “أقامه الله ناقضاً أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكناً أن يُمسكَ منه” (أع 2: 24). فقد أقامك الآبُ بالروح المحيي، الروح القدس (رو 8: 11)؛ لأنك حياةٌ تحرر وتطلق سراح بني الموت. بك وفيك على الصليب أحيانا الآبُ معك (كول 2: 12).
– “بذل ابنه الوحيد” (يوحنا 3 : 16).
– “لم يبخل([1]) بابنه، بل بذله لأجلنا” (رو 8 : 32).
– “بذبائح ومحرقات …. بل هيَّأتِ لي جسداً” (عب 10 : 5).
– مكتوبٌ عنِّي “أفعل مشيئتك يا الله” (عب 10 : 9).
هكذا كانت المحبة الواحدة، محبة الآب والابن والروح القدس.
ولا زال الآبُ يقدِّمُ ابنه لنا في كل قُدَّاسٍ، ولا زال الابنُ يقدِّمُنا للآب: “رَفَعَ قديسيه … وقدَّمه قرباناً لأبيه” (قسمة سبت الفرح). ولا زال التدبيرُ دائمٌ حتى نهاية الدهور.
-7-
لماذا يخافُ الشيطانُ مِن علامةِ الصليب؟
استلمنا من الآباء أنَّ علامةَ الصليبِ تُرعبُ الشياطين. هكذا علَّمنا أنطونيوس الكبير. ويقول رسولُك الكريم إنك جئت لكي: “تبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس” (عب 2: 14).
سلطانُ الموتِ يا مخلِّصي هو في “الشَّرِّ اللابسِ الموت” (صلاة الصلح)، وهو حيث تسودُ الظلمةَ، والبغضةَ والقتل. ولكن موتَكَ أباد الموتَ، وأشرقَ بنورِ الغفرانِ الذي يكرهُهَ الشيطانُ، فهو “عدوُّ المحبة”. يحاربُ المحبةَ مرةً بخداعِ القوةِ؛ لكي نسلكَ طريقَ القوةِ، ومرةً بالإيحاء بأنَّ الغفرانَ ضعفٌ؛ لكي نثأر.
يكره الشيطانُ المغفرةَ؛ لأنه “المشتكي”، و”المُهلِك”.
عاشقُ الانتقامِ يرى علامةَ الصليبِ فيرى القُبحَ الذي يملأ ذاته. يرانا نتحصن بالمحبةِ، وهي نورُكَ يا يسوع، فيهرب. يسمع صوتُكَ الظافر مبشِّراً بنهاية الدينونة التي يفتح هو براكينها؛ لأنه مدمِّرٌ، فَيَفِرُّ.
ليس هناك فرقٌ بين اسمِكَ وعلامةِ انتصارِكَ. الصليبُ صفةٌ شخصيةٌ؛ لأنك أنت يسوعُ المصلوب، و”المصلوبُ” اسمُ انتصارِكَ، مثل صليبِكَ …
كُنَّا نسمعُ الجدودَ يقولون لنا: “باسم الصليب”. ولكِنَّا كُنَّا صغاراً لا نفهم. ولكن، عندما التصقنا بكَ، وأشرقتْ محبتُكَ فينا، أدركنا أن “باسم الصليب”، هي باسم القوة الغالبة للبغضة والكراهية وكل أنواع الشر.
– الصليبُ هو نورُكَ الذي أشرق في ظلمة الكراهية.
– نعمتُكَ التي فاضت بالمصالحة.
– صعدتَ إليه، فصار مذبحَ الفداءِ.
حَمَلَ الصليبُ حياتكَ التي ارتفعت على الجلجثةِ؛ لكي تفتح باب الفردوس لمن عصى.
سَقَطَت اللعنةُ وأُدينتْ الدينونةُ، فصار الصليبُ علامةَ حياةٍ تُرعبُ مَن يكره الحياةَ، وفقد الشيطانُ كلَّ أسلحة الموت وسلاسل عبودية الموت التي بها أسرنا وقيَّدنا، فصار الصليبُ نوراً وأساساً للحياةِ، فَزِعَ منه الشيطانُ كارهُ الحياةِ.
([1]) ترجمة بيروت – فان ديك – لم يشفق على ابنه – هذا تجديفٌ فاضح؛ لأن عدم شفقة الآب على الابن المتجسد، تصبح عدم شفقة علينا نحن؛ لأننا نحن فيه، أي الابن المتجسد.


