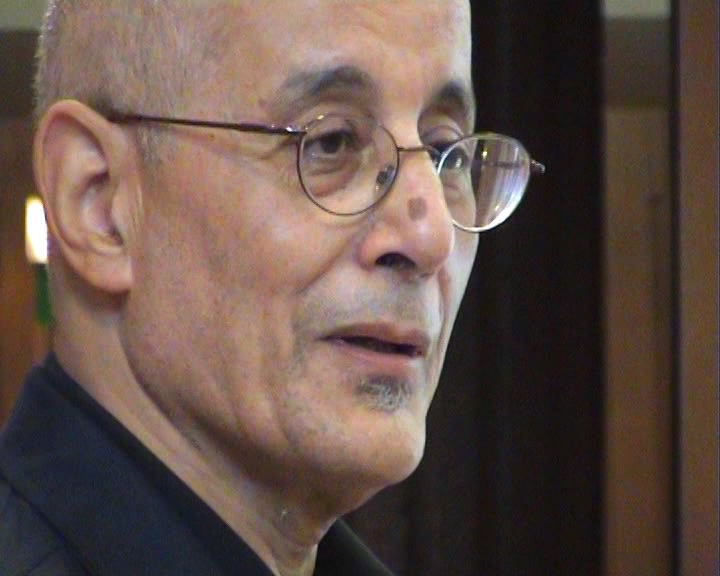يسوع المسيح حياتنا
العنوان أُخِذَ من أوشية الإنجيل: “لأنك أنت هو حياتنا كلنا”.
رسائل الأخوة والأخوات تؤكد لي حاجتنا الشديدة جداً إلى أن نغوص معاً في “سرِّ المسيح”، وهو اتحادنا بالرب يسوع، ومع أننا نشرنا دراسة وافية على موقعنا بعنوان: “المسيح والمسيحي وشركة الجسد الواحد”، إلَّا أننا على ما يبدو لي، نقرأ ما في عقولنا قبل أن نقرأ ما هو مكتوب، حتى وإن كان المكتوب هو كلمات الروح القدس في الكتاب المقدس.
ماذا ضاع منا، وما هي الأسباب الحقيقية لهذا الضياع؟
يتأرجح فكرنا المصري (لا فرق بين أرثوذكسي وإنجيلي …. الخ) بين إلوهية الرب يسوع، وهذه حقيقة أزلية، وبين إنسانيته، وهي حقيقة أبدية سوف نحيا معه، هنا وفي الدهر الآتي؛ لأن الله أعلن عن نفسه في تجسد الكلمة (يوحنا 1: 14)، وهو آخر استعلان طبقاً لـ (عب 1: 1). ولكننا لم نستوعب بعد حقيقة اتحاد الرب الابن الكلمة بالإنسانية التي أخذها من والدة الإله.
أصبحتُ أتردد في استخدام كلمة “الناسوت” السريانية الأصل؛ لأنها تحوَّلت إلى فكرة، إلى الدرجة التي صار معها اسم “الجسد”، اسماً مجهولاً، ولذلك عندما نشير إلى الإنسانية، لعل الوعي يستيقظ ويصحو على حقيقة “تأنُّس” الله الكلمة. وما نقوله هنا ليس بدعاً، فقد أدركت أجيالٌ أخرى سبقتنا في الوجود، أن تعبير “تجسَّد” لم يعد يكفي، ولذلك أضافت حسب القبطي: “تجسد وصار إنساناً”، أو “تأنَّس” حسب ترجمة العصر الوسيط.
ولكي نعبر هذا التأرجح، يجب أن نستعيد الوعي بالتجسد، واتحاد الله الكلمة بنا نحن البشر: “هذا الذي لأجلنا نحن البشر ولأجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم” (قانون الايمان). هذا يكشف لنا أن الآباء في نيقية 325 لم يفكروا في حدثٍ خاصٍّ بالله الكلمة وحده، بل “لأجلنا”، وهو من خلال ما نعرف من كتابات الآباء الذين سبقوا نيقية 325 والذين عاصروا نيقية 325 أن الرب جاء لعودتنا نحن البشر إلى الآب كأبناء ننال كياناً جديداً غير ذلك الكيان الذي دمَّره آدم الأول، وأن هذه العودة هي اتحادٌ وثيق لا يقبل أيَّ شكلٍ من أشكال، أو أيَّ نوعٍ من أنواع الانفصال (رو 8: 39)؛ لأنه اتحادُ محبةٍ لا تقبل الانقسام.
إذن، نبدأ الوعي بالتجسد، أو أن “صار الكلمة الله إنساناً مثلنا في كل شيء بلا خطية” (عب 4: 15).
ماذا يعني هذا في الواقع بعيداً عن كل ما قيل وما يمكن أن يُقال من نظريات؟
* يعني أولاً أن اتحاد الله الكلمة بنا هو اتحادُ حياةٍ إنسانية، أي حياتنا نحن بحياته الإلهية المتجسدة.
وهذا يعني أن الرب يسوع المسيح يتجلى في الجسد الإنساني إنساناً، وُصِفَ بأنه يحب الطعام ويشرب الخمر (متى 11: 18)، بل ويحيا مع أحط طبقات المجتمع الإنساني: الزناة – العشارين، أي جامعي الضرائب – صيادي الأسماك، وهو لا يخاف ولا يتردد في أن يقابل رؤساء مجمع مثل نيقوديموس. فهو ليس شخصاً ينزوي خوفاً أو خجلاً، لأنه جاء من أجل استعلان أعظم ما يُقال عن الله، وهو أن “الله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم”، وأضاف الإنجيلي يوحنا “لكي نحيا به” (1 يوحنا 4: 9) فكيف نحيا بالمسيح؟
* هذا يعني ثانياً أن نؤمن بالحياة الإنسانية التي لنا. يبدو هذا غريباً على من يقرأ، ولكن يجب أن ننتبه إلى أن الإنسانية التي فينا هي إنسانية تغرَّبت عن الله، وعن مصدر الحياة حسب قول رسول الرب: “بلا إلهٍ في العالم” (أفسس 12: 11)، وهذه الكلمات قيلت لمن كان يعرف آلهة الأمم، أي الآلهة الوثنية. لكن لم يكن لدى هؤلاء، “الإله الحي”، إله المواعيد والعهد والأنبياء، والإله الذي يكشف عن ذاته “الله بعد أن كلَّمَ الآباء” (عب 1: 1).
واغتراب الإنسانية عن الله يعني أننا خلَقنا لأنفسنا آلهةً مزيَّفةً، وبالتالي زيَّف الإنسانُ حياته (نرجو قراءةً غير مسرعة لكتاب الرسالة إلى الوثنيين – القديس أثناسيوس – ترجمة د. جوزيف فلتس).
الإنسان هو ما يعبد. هذا صحيح، ولذلك في قلب العالم الوثني القديم، رتَّل شعب الله هذه الكلمات:
– أصنام الأمم فضة وذهب
– عمل أيدي الناس
– لها أفواهٌ ولا تتكلم
– لها عيونٌ ولا تبصر
– لها آذانٌ ولا تسمع
لكن ما هو مرعب حقاً هو العبارة التالية:
– مثلها يكون صانعوها وكل مَُن يتكل عليها” (مزمور 135: 16-18)، ولذلك كانت عبارات المزمور تجعلني ارتجف من تعليم العصر الوسيط عن الآب الغاضب على ابنه إلى درجة قتله؛ لأن مَن يعبد هذا الآب الغاضب لن يفارقه الغضب؛ لأنه عندئذٍ يكون مثل الإله الذي يعبده.
الكلمة يتجلى إنسانياً ويُدخِل ألوهيته في “صميم” الحياة الإنسانية، كما كان الأب متى المسكين يقول ويكتب لعشرات السنوات مضت. وهو لا زال الكلمة المتجسد في السماء. أخذ خدمة رئاسة الكهنوت حسب رسالة العبرانيين لكي “يكفِّر عن خطايانا” (عب 8: 14). أي لكي يطهِّرنا حسب كلمات العبرانيين: “بعدما صنع تطهيراً” (فداءً) لخطايا جلس في يمين العظمة في الأعالي” (عب 1: 3). هنا يجيء دور الترتيب الكنسي المفقود والضائع، -وأنا أقصد التسبحة- والذي أعاده البابا كيرلس السادس، وإن كان يوشك أن يتلاشى في وسط صراعات حول الموسيقى والألحان.
لأن الذي صَنَعَ هذا التطهير ولا يزال يصنعه هو -في التسابيح اليومية والأسبوعية:
– خالق السماء والأرض (يوحنا ص 1).
– حامل كل الأشياء بكلمة قدرته (عب 1: 3)، أي حافظ كل خليقة في مدارها، وهو الذي يحفظ حتى “المجرات” البعيدة التي لا نراها.
هذا ما تزرعه فينا الهوسات (التسابيح) كل يوم لكي لا نفقد الوعي، وتضيف إليه تسبحة أو ترتيلة لاسم ربنا يسوع باسم “الإبصالية” على مدار الأسبوع.
لذلك يجب أن نطهِّر الفكر من صورة الرب المعلَّق على الصليب والميت؛ لأنه الحيُّ في الموت، والغالبُ بالضعف، والقادر أن يعطي مكاناً في الفردوس للصٍّ آمن به وهو معلقٌ معه على الصليب.
المطلوب إذن هو استرداد الوعي بقوة الرب المتأنس الذي يستعلن هذه القوة خفيةً أو سرَّاً.
والسرُّ هو الاستعلان الذي لا مثيل له في الواقع الإنساني، ولا يوجد حتى ما يقابله أو يشرحه. هو استعلانٌ يتعدى كل ما هو ملموس ومعروف ومألوف، ولكنه يدخل إلى أعماق الإنسان المؤمن، وغير المؤمن؛ لكي يستعيد الإنسان ويعيده إلى الآب. لأنه هو الراعي الذي يبحث عن الخروف الضال ولا يتوقف حتى يجده.
إخلاء الذات (فيلبي 2: 6-8):
إن تدبير الخلاص لم يمحو ألوهية الرب، بل أدخل هذه الألوهة مجال الضعف والتعب والنوم والأكل، وهو مجال الحياة الإنسانية التي اتحد بها الله الكلمة.
لذا أرجوك عزيزي القارئ، ألَّا تغرق في حوار ومتاهات العصر الوسيط الذي ركب رأس العصر الحديث عندنا: هل الله يأكل ويتألم … الخ هذه ترَّهات وأضاليل تُقال لكي نفقد الوعي بالتجسد، ونقسِّم الواحد إلى اثنين لكي نبقى في تراب الأرض حشرات ليس لها مجال الحياة السماوية.
أذكرُ واقعةً فيها نوع من الفكاهة، عندما كان أحد الخدام يحاور القمص مينا المتوحد عن نوم وتعب الرب، بل وموته. وقال أبونا مينا وهو يبتسم: يعني لما بتأكل، عقلك بياكل ولا بقك؟ وسكت الأخ. ولما بتنام، جسدك بينام ولا روحك؟ وسكت الأخ. ذلك أن فصل أفعال الإنسان إلى جسدانية وروحية، هو تقسيم للإنسان. طبعاً، العقل لا يأكل، ولكن العقل يفهم. وطبعاً، الروح لا تنام في سبات مثل الجسد، ولكنها تهدأ. وإذا قال الكتاب عن النفس: “أنا نائمة وقلبي مستيقظ” (نش 5: 2)، فهذا عن الحياة والوعي بالصلاة الدائمة.
لقد ضرب الضلال حتى جذر اتحادنا بالرب في سر الشكر، عندما قيل إننا نأخذ الناسوت فقط.
لكن إخلاء الذات يعني إخفاء اللاهوت في الحياة الإنسانية، واستعلان هذا اللاهوت في القلب، أحياناً بشكل منظور، ودائماً بعمل خفي.
والرب لا زال يخلي ذاته بالحياة فينا، وبعطية الجسد والدم التي توزَّع على كل البشر، وتبقى قضية الاستحقاق قضية شخصية، بمعنى أنه لا توجد أية موانع عند الرب، إلَّا الموانع التي يصنعها الإنسان لنفسه مثل الارتداد أو البقاء في الشر.
الرب يدخل حياتنا والأبواب مغلَّقة تماماً، كما حدث في العلية، ولكنه يستعلن ذاته في قوة مقاومة الفكر الشرير، وفي تثبيت الحياة فيه. هو يدخل من ثقب إبرة اسمه المحبة، وهو ما لدينا جميعاً. “حيث المحبة، يحل الثالوث”. في محبة الأم أو الأب أو الصديق. هذه هي إشعاعات المحبة الإلهية في شكلها الإنساني. أما في شكلها الإلهي، فهي النار التي سُجِّلت لنا في تاريخ القديسين، الذين اشتعلوا بنارٍ إلهية مثل أرسانيوس ومكسيموس ودوماديوس وبفنوتيوس، هؤلاء صاروا مثل العليقة حيث اللاهوت دون أن تحترق الشجرة، بمعنى أن هؤلاء بقوا بشراً وعاشوا بشراً وماتوا أو رقدوا في الرب بشراً.
وشهادة الروح القدس تجدها في مقاومة الإغراءات، وفي التمسك بالوصايا: “مَن يحفظ وصاياه يثبت فيه، وهو (يسوع) فيه، وبهذا نعرف أنه يثبت فينا من الروح (القدس) الذي أعطانا (1 يوحنا 3: 24) والذي نال الروح القدس في العلية بعد القيامة (يوحنا 20: 22) يعرف أنه أخذ الروح القدس.
العواطف هي أحد الموانع الحقيقية التي تزرعها العبادة الوثنية:
درستُ العبادات الوثنية – الكنعانية – المصرية – البابلية – الفارسية، ثم ما وُلِدَ داخل الجماعة المسيحية – مدارس الغنوسية، بل حتى أوراق أو مخطوطات البحر الميت، كانت أحد برامج الدراسات العليا في كامبريدج. وكانت قراءة ما تبقى من صلوات وعبارات هذه الجماعات تكشف عن:
– عطشٍ إنساني حقيقي إلى الخالق، ولكن العطشان يضل الطريق عندما يقاد إلى طقوسٍ معقَّدةٍ تهدف في النهاية إلى رد الإنسان إلى كيانه؛ لأن الله الحقيقي غير معروف.
– وعودة الإنسان إلى ذاته من خلال العبادات، كانت تتم بطقوس معقدة ولازلت حتى تاريخ كتابة هذه السطور أحاول أن أفك طلاسم كتاب قبطي غنوسي بعنوان يوناني هو Pistis Sophia الإيمان – الحكمة .. والغموض هو غموض عواطف الباحث عن حقيقة، تخدعه عنها الطقوس، إذ تعيده إلى النقطة التي بدأ منها، وهي الذات، فلا تزال الذات self هي مشكلة الصراع الروحي في العصر الحديث في أوروبا، وهو صراعٌ تخوضه البوذية بكل مدارسها بعنف شديد ضد المسيحية الغربية.
غموض العواطف عندنا قد يثيره مثلاً معنى: “حمل خطايانا في جسده على الخشبة” (1 بط 2: 24)، عبارة تصبح غامضة لو لم يكمل الواعظ الباقي، وهو: “لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر”؛ إذ لا يريد التعليم الذي شرب من مياه العصر الوسيط الراكدة أن ينقل الصليب إلى الواقع الإنساني، بل أن يتحول إلى قضية غنوسية (عرفانية) تمَّت في الماضي. فالموت عن الخطايا هو الالتصاق بالمسيح يسوع المصلوب معنا وفينا حسب كلمات الرسول: “مع المسيح صُلبت”، ولعلنا ننتبه إلى أن بولس لم يحذف حياته، بل أضاف: “فأحيا (وحرف النفي) لا أنا (أي الحياة القديمة)، بل المسيح”، وذلك حسب التعليم والمثال الذي يصرخ بعد ذلك به “الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد (اعتبروا الجسد ميتاً) مع الأهواء والشهوات. وهؤلاء هم الذين نالوا سكنى الروح القدس (راجع غلا 2: 20) مع غلا 5: 16-26).
لقد تم تقطيع العهد الجديد إلى مقاطع تقال من أجل إثارة العواطف الغامضة، إن في الوعظ، أو في ترانيم تضم أكبر قدر من العموميات Generalities وهو مجال يطول البحث فيه (وإن كنا قد تعرضنا له بسرعة في مقالاتنا عن التقوى المزيَّفة التي تفتقد إلى الأساس اللاهوتي)، ولكن لكي نتجنب هذا الفخ الذي يعود إلى الوثنية المتأصلة في الوجدان الانساني علينا أن نراقب ما يلي:
1- إن كل عاطفة لا تنتهي بقرار إرادي واضح، هي فخٌ يؤدي عادةً إلى الإحباط والإدمان على الاجتماعات، بل والقداسات أيضاً.
2- إن القرار الإرادي هو قرارٌ مشترك بيني وبين المسيح؛ لأنه هو قرار المسيح الرب قبل أن يكون قراري أنا؛ لأن كل عمل صالح قد سبق الآب وأعلنه في حياة الابن: محبة الاعداء – الغفران للصالبين – تقديم ذاته ذبيحة .. هذه كلها تأتي إلينا عندما يحل روح الرب فينا، هي عمل الروح القدس حسب اتساع قلب كل إنسان، وهو عملٌ قد لا يكون مصحوباً بعاطفة أو شعور، وإنما هو دائماً استنارة: “لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن”. هل تعلم ماذا يقول الرسول بعد هذه الكلمات؟ “ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة .. وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة (التي لا يمكن أن تخضع لنظريات العقل) لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله (أي ملء محبته؛ لأن محبته هي الألوهة الحقة)” (أفسس 2: 16-19).
3- إن الاستغراق في التحليل اللغوي لفرض قواعد اللغة على الإيمان، أو محاولات إغراق المستمع في تفاصيل تاريخية تشتت الذهن، مثل حديث طويل عن السامرة، أو تحليل كلمات الرب للوصول إلى طرح الاستعلان في بحر الرموز والاستعارات مثل: “أنا الكرمة وأنتم الأغصان، كل غصن فيَّ …”، فعندما تنقل هذه العبارة إلى مستنقع الاستعارات، ولا تقارن بما يقوله الرب نفسه: “اثبتوا فيَّ وأنا فيكم”، أو الاستعلان الإلهي في يوحنا ص 17 فإن الواعظ يكون عندئذٍ نبياً كذاباً. وما أكثر الأنبياء الكذبة الذين حولوا الكلمة المتجسد إلى كلمات تقال.
خداع العواطف:
للإنسان ميلٌ طبيعيٌّ للامتلاك. هو يريد أن يمتلك، لو استطاع العالم كله. لقد جرَّب الشيطانُ الربَّ يسوع نفسه، وقدَّم له رؤيا عقلية: “ممالك المسكونة في لحظة من الزمان” (لوقا 4: 5). ولاحظ أن استعلان الله على جبل حوريب يقابله هنا جبل التجربة. وقال الشيطان: “لك أُعطي هذا السلطان كله ومجدهن لأنه قد دفع لي وأنا أعطيه لمن أريد” (لوقا 4: 5)، وكان المطلوب هو أن يعبد يسوعُ الشيطانَ، ويسجد له لكي يصبح مثل الذي يعبده. وهكذا تبقى فينا رغبة الامتلاك، رغبة الحصول على كذا وكذا … الخ. ولكن هذه الرغبة تنجرف إلى ما هو شرير؛ لأن مصدرها العواطف الغامضة التي لا ترى العاقبة، ولا ترى النهاية.
النعمة لا تُمتَلَك، والحياة الأبدية هي شركة، وهي ليست تحت سلطان إرادة الإنسان؛ لأن ما نشترك فيه مع آخرين حتى على المستوى الإنساني، هو ما لا يخضع لإرادتنا وحدنا، بل الشركة تُعلم الإنسان العطاء.
وكم كان فظيعاً أن يُقال إن حلول الروح القدس فينا يحوِّلنا إلى آلهة مثل الله. هذا هذيان مَن لا يعرف النعمة. وهو هذيانٌ أطلقه الشيطان؛ لكي يخيف أولاد الله. أذكر عبارةً في مديحةٍ للمسعودي تقال في شهر كيهك:
وحش نبي كذاب، أضلَّ أولاد الآب.
لأننا نعرف حقاً أن كل شيء هو في المسيح، أي نشترك فيه، وهو ما توسعنا في شرحه في كتابنا “المسيح والمسيحي وشركة الجسد الواحد”.
العواطف غامضة هوجاء تعلو وتهبط، ولكن الإرادة التي وُحِّدَت بالروح القدس لا تعرف اندفاعات العواطف، ولا عواصف الانفعالات.
د. جورج حبيب بباوي