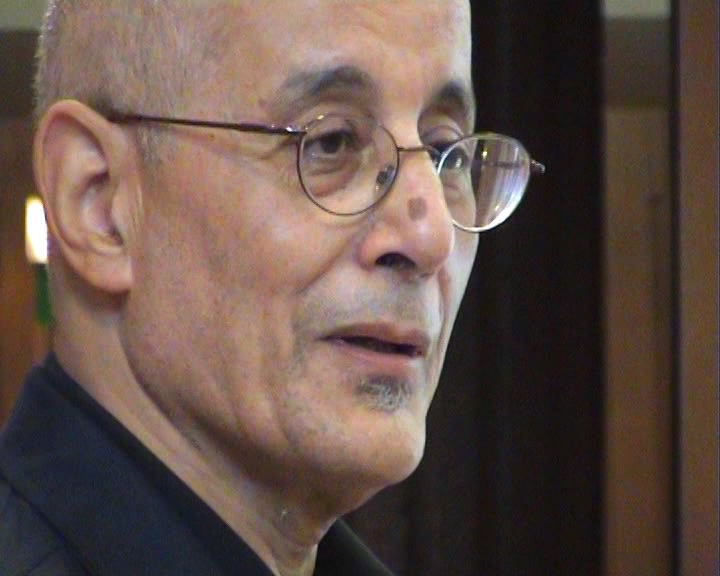 تنقية القلب والإرادة- 2
تنقية القلب والإرادة- 2
ليس لدينا تعليم مسيحي شرقاً وغرباً يقول إن الإنسان يخلص بالأعمال الصالحة، وليس لدينا تعليم أفرزه الإنجيليون عن التبرير بالأعمال، أو تعليم عن حساب بر المسيح للخاطئ. هذه كلها معاً: الخلاص بالأعمال الصالحة، وحساب بر المسيح للخاطئ، هي خزعبلات العصر الوسيط.
كان أبي يعلمني أن المحبة هي أساس “الخلاص الأبدي”. لاحظ كلمة “الأبدي”، وليس مجرد الإقلاع عن عادات سيئة أو التوبة بمعنى الكف عن الخطايا. هذا المعنى كان هو السائد في فترة طويلة امتدت من الأربعينات في القرن الماضي حتى عصرنا هذا. ولكن “الخلاص الأبدي” هو اكتشاف المحبة الإلهية على النحو الذي ذكره رسول الرب في (1كو 13: 1-10). وكان أبي يقول أيضاً إن ما أورده الرسول عن المحبة هو رسمٌ لأيقونة المخلِّص الرب يسوع المسيح له المجد.
الأساس الرسولي للمحبة هو: كل مَن لا يعرف المحبة لا يعرف الله (1 يوحنا 4: 7 – 8). ويجب أن نضيف أيضاً أن: “محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس ..” (رو 5: 5)، وعلى ذلك، فالتوبة الحقيقية هي تغيير الحياة، وهذا هو صراع المحبة الإلهية معنا وفينا:
– أن تحب الرب يسوع كنفسك؛ هو ما يجعلك تحيا بشكل مختلف.
– أن تجعل الرب يسوع أهم من كل ما تحب.
– أن تصبح محبة المسيح في قلبك هي سبب محبتك للآخرين.
هذه ليست خطوات مثل خطوات صعود السُّلَّم، بل هي صلاة يسوع. وما تذكره الإبصاليات بالذات، هي حسب كلمات إبي: “المجال الإلهي لعمل الرب يسوع وإشراقه بالنور الإلهي في قلب كل مَن يدعوه”.
الأعمال ليست ثمرة للإيمان كما يُقال، ولا هي ثمرة للمحبة. كل هذه التعبيرات لها خلفية نسكية مزوَّرة تؤدي إلى تقسيم الكيان الإنساني.
قال لي: “لنبدأ من أول الحكاية. الإرادة هي عزم الإنسان، وهو يجب أن يكون عزم المحبة، وليس مجرد فكرة في قلبك وضعتها للتنفيذ.
– القرار الإرادي هو الاتحاد بالرب يسوع وهذا يعني -أول الكل- أن يكون كيانك (الجسد والروح) ملكاً مشتركاً بينك وبين المخلِّص والفادي. عندما يملك المسيح على حياتك ومشاعرك ووجودك، فهذا يعني أنك لا تملك ذاتك لذاتك، بل تملك ذاتك للرب يسوع.
– كل الشرور والخطايا تأتي من مصدر واحد، وهو شعور الإنسان بالاستقلال عن الرب. انفراد الإنسان بوجوده([1]) لكن علينا أن نحب الرب حقاً لا بالعواطف، ولكن بالممارسة. ليس بالشعور؛ لأن (العواطف هي باب خداع القلب)، ولكن بالعزم؛ لأن العزم له أساس أن كيانك ووجودك ليس لك. هذا لا يجعلك مثل من أصيب بالشلل، بل يجعلك حُرَّاً من كل الصراعات التحتانية (اللي تحت مراقبة الضمير والشعور)، أي ما هو خفي (جُوَّة، جُوَّة في القلب). لن تملك الرب يسوع طالما أنت مستقل عنه، ولكن استقلال ذاتك يجب أن يكون القوة الذاتية التي تجعلك تطلب دائماً الرب كلما أحسست بالابتعاد عنه.
– الرب يسوع هو حياة، وليس برشامة أسبرين تأخذها لمَّا تكون تعبان. هذا التصرف، أي البحث عن الراحة والعزاء في المسيح فقط بدون الاتحاد به، هو ما يهدم المحبة؛ لأن المحبة الحقيقية هي في طلب الرب لشخصه فقط، وليس لأي أمرٍ آخر.
– كان عندنا في الدير أب مريض تعبان، ولكنه كان يقول للرب يسوع: (الجسد ده بتاعك أنت، اعمل فيه اللي أنت عاوزه. أنا مش هَطلب الشفاء، ولكن هَطلب أن يكون جسدي ذبيحة حية مقبولة عندك).
– العزم الحقيقي نابع من الاتحاد، لا بقرار الإرادة فقط. والقلب يراقب ويرى كل يوم، بل كل ساعة -على قدر تقدُّمك في المحبة- مدى صحة محبتك.
– إذا فضَّلت لنفسك أي شيء، فلا تنزعج، طالما هو خير وصالح. كل مطالب الجسد مثل النوم – الأكل – الملابس – هي أمور صالحة مقدسة؛ لأنك تفعل هذه الأمور من أجل محبتك للرب”.
قال والدموع في عينيه: في أول طريق الرهبنة قِيل لي إن جحد الذات هو رفض الإنسان لكيانه وحياته”، وأنا تعبت من هذا الكلام، ولكن واحد من شيوخ الدير -لم يذكر اسمه- قال لي: يا مينا حِبْ الرب يسوع لنفسك. هذا هو طريق جحد الذات، وهو الطريق الرسولي. وأصبحت أسير في الاتجاه الصحيح.
– يا ابني لا يمكن للإنسان أن ينكر وجوده، ولكن يمكن لكل إنسان أن يفهم معنى قول الرب: “انكر ذاتك واحمل صليبك، أي ذاتك المصلوبة، ثم اتبعني، أي اتَّحد بي في طريق الحياة”.
– إغراءات الخطية لا تأتي من الخارج فقط، بل من الداخل أيضاً. وقد تأثرت بشكل لا يوصف عندما قرأت في سيرة الأنبا صموئيل المعترف أن البرابرة الذين أسروه قد ربطوه في سلسلة مع جارية لكي يزني معها. ولكن قلبه المشغول بمحبة الرب جعل حتى إغراءات الخطية تتلاشى.
– إذا انكسر عزمك، أو تغيَّرت إرادتك، فلا ترتعب ولا تجعل لليأس مكاناً. العودة إلى الخطية أو إلى الكسل معناه أن في القلب “جُوَّة جُوَّة” رغبات وشهوات لم تُكتَشَف، ومع الحزن يجب أن يكون لدينا رجاء في أن نكتشف ما هو في داخل القلب الذي أعادنا إلى سيرة قديمة، أو ذكريات باطلة بلا نفع. محبة الله التي توهب بالروح القدس تبيد كل ما هو باطل.
– تذكَّر كلمات الرسول بولس: “أنسى ما وراء”، وتذكَّر أيضاً كلمات الرب نفسه: “مَن يضع يده على المحراث ونظر إلى الوراء لا يصلح لملكوت السموات”؛ لأن النظرة إلى الوراء معناها نسيان الهدف. كان الأنبا أرسانيوس يقول: أرساني تأمَّل (في الهدف) الذي لأجله خرجت من العالم” وعندما يصبح الرب هو هدف ووسيلة حياتك، ستجد العزم الصالح؛ لأنه نار المحبة الإلهية المشتعلة في القلب.
([1]) كان ابونا فليمون المقاري يقول: “الانسان الفرداني هو محب لذاته فقط”!!



تعليق واحد
كيف تُخرِجَ الفلسفة طبيعتنا عن حدود خلقتها؟
وضع علىّ أن أشارك برؤية, كإضافة فى الأتجاه المعاكس, لعل يصل ميزان حياتنا إلى نقطة الإتزان المطلوبة, لتلحق أجسادنا الثقيلة بركب إستعلانات السماء, ولقد تحيرتُ بالفعل من أين يجب أن تكون البداية, لأن الموضوع المطروح له أطراف كثيرة فى كل دقائق حياتنا, وإن طرحه بهذه البساطة, لَيؤدى بنا إلى إدراك مختصر لحقيقة لا يمكن إختصارها, والذى سيخل بوعينا لأصول نشأتنا, وهذا ينعكس بطريق مباشر فى بناء أسرنا وتربية أولادنا, وهذا يشكل العائق الأول والأساسى, كعدو متيقظ لإستمرارية إجتماع كنيستنا.
لذا وجب علينا إرجاع الحديث لأصوله العلمية والروحية, ليكون بنائنا لأفكارنا اللاهوتية, بناءً واقعياً يمس حياتنا, وليس مجرد إستحسان لمنطق لاهوتى, وإستعذاب لأفكار فلسفية, لنتبنى تأويل خاطئ لإرادة الله, الذى وضع كل ما أراده وأستحسنه فى الطبيعة الإنسانية التى خلقها.
إذاً فالحل هو دراسة الطبيعة الإنسانية, وما علينا سوى تفعيل الإدراك الحسن لحقائق وجودنا, فكل ما يلائم هذه الطبيعة هو من إرادة الله ورغبته وحكمته فى الخليقة, وعلينا ان لا نحزن إن تعارضت مقومات طبيعتنا مع منطقنا اللاهوتى الحالى, فهذا إنما يكشف مدى الاسترسال الخاطئ, والشطط الفلسفى الحاد الذى ضرب علم اللاهوت فى مقتل, قصدنا كل علوم اللاهوت فى كافة ارجاء المسكونة, فوجود مثل تلك المضادات فى التعليم اللاهوتى, إنما يكشف عن مدى القيود التى وضعتها الفلسفة, لتكبل إنطلاق لاهوتنا لبناء الانسان كما أراد الله له, فقد خلقه بكينونة معينة, لابد ان ندرك مقوماتها جيداً, فنحترمها فنشفى فنثمر ثلاثين وستين ومائة, ولذا فأنه من الضرورى أن نبتعد ونحترس من مفهوم الإنسان كما تُعَرِفَهُ الفلسفة, لأنه يكشف مدى قصور الفلسفة عن فهم الإنسان, وبالفلسفة صارت طبيعة الانسان متغربة عن أصولها فى علومنا اللاهوتية, غريبة عن طاقات نموها التى وضعها الله بها, التى ترتبط أرتباط مباشر بقانون الزمان والمكان.
أما إن تحدثنا عن عمل المحبة الإلهية كنعمة غير مخلوقة, كعمل إلهى يعمل بأتوماتيكية الآلهه, لنعايشه فى الواقع فى كل أحداث حياتنا, فهو حديث المحبة بصياغته المطلقة, ولهو شئ محزن حقاً, لأنه لا إطلاق على الإطلاق فى حياة البشر, فنحن نرجو المطلق ونأمله, وكلنا ثقة ممتدة فى تكميل السماء لنقص حدود إمكانيتنا, وضيق إستيعابنا, ففى حياتنا العامة والكنسية لا وجود لحرية مطلقة ولا لمحبة مطلقة, فهذا مجرد وهم الفلاسفة والشعراء, كالمدينة الفاضلة بالضبط.
فلا وجود لأى شئ فى صياغته المطلقة, وإنما يوجد فقط فى صياغته النامية للكمال, لأن ما يحول بيننا وبين المطلق هو الزمن نفسه, والذى يصب كل سيطرته وتحكمه فى حياتنا لصالح وجودنا المكانى, فطالما الوقت والزمن يتحكم فى كل شئ فى دنيانا, فنحن لن نستطيع اختراق حدود المكان أيضاً, فلا تحدثنى حديث المطلق, فهذا لا يناسبنى مع انه يناسب الله, وانما يناسب رجائى وإشتياقى لكمال الإتحاد بالمسيح, وهذا هو ما قصده الله من ان نمتلئ لكل ملء قامة المسيح, فهذا ما ننمو به وإليه, لنكتشف بعدنا الأبدى لنعدو خلفه فى زماننا, لندركه بالحق فى تكميل خلاص أجسادنا.
وعلمنا الرب إنه يجب علينا ان لا ننسى بعدنا اللازمنى اللامكانى كصلاة دائمة, نطلبه بلجاجة رجاءنا, لأجل التكميل المذخر لنا فى المسيح يسوع, فسمح الرب بوجود السواح كنموذج حىّ, كفئة قليلة جداً تذوقوا شعاعاً واهناً من كمال حياتنا فى يسوع المسيح, فخرجوا هائمين على وجوههم غير مبالين لا بطعام ولا شراب ولا مسكن, متجاوزين ثقل امراض أجسادنا, لا يعرفون من اين يأتون, ولا إلى أين يذهبون, فيخترقون حواجز الزمن, ويحرقون قيود حدود المكان, إلا أنهم سرعان ما يعودون لنقص وحدود الطبيعة الإنسانية, فيتقبلون الموت, فتتحلل أجسادهم تحت متطلبات الزمان والمكان.
أما كنيستنا الواعية المتيقظة لحياتنا دائماً, تعلمنا بأصول الوعى الحقيقى الذى يجب أن يكون, ويظهر لنا هذا جلياً فى جميع صلوات ليتورجيتها, ليعلو صوتها دائماً بالأحترام والخضوع لحقيقة أبعاد الزمان الثلاثة للحياة الأنسانية, التى لا يمكن تجاوزها, وهى:
الماضى والحاضر والمستقبل
فكنيستنا الحكيمة فى صلواتها لا تُغَلب بعد على الأخر, وإلا إنكسر نمونا الزمانى الروحى, الذى هو الأساس لخلقتنا, والذى من المستحيل تعطيله لحساب محبة مطلقة, لأنه لو كانت تلك المحبة المطلقة موجودة بالفعل فى حياتنا بكامل طاقتها, لتعطل الزمان وسقطت حدود المكان!!
أما أن أعترفنا بقيام الزمان والمكان فى حياتنا, قياماً دائماً وصارخاً, فهذا دليل كافى على وهمية عمل المحبة المطلقة بكل إطلاقها فى حياتنا.
فلنبدأ إذاً بأستعراض مبسط لأحترام كنيستنا لأبعاد الحياة الأنسانية الثلاثية:
– التسبحة مثلاً -بل وكافة صلوات ليتورجيتنا- إنما تحترم جداً كل العهد القديم بأنبيائه, وبأحداثه وثقافته, التى من المؤكد انها تختلف أختلافاً متبايناً واضحاً عن ثقافة عصرنا الحالى, إلا إنه يجب علينا إحترامها كإحترامنا لسذاجة طفولتنا وهفوات شبابنا, فحياة الإنسان لا يمكن تفتيتها وبتر أجزاءها, فكنيستنا الواعية بوعى الروح القدس, تحترم وتقدر ماضيها مهما قيل فيه, وإلا ماتت وأنتهت هى نفسها.
لأنه بالحق لا وجود لأحداث ماضية ميتة على الإطلاق, فالماضى لا يموت أبداً!!
فرؤية كنيستنا الرشيدة للتاريخ تختلف تماماً عن الرؤية المزرية لكبير الشعراء نزار قبانى حينما قال:
” أن التاريخ هو علم الحوادث الميتة”!!
فلا وجود إذاً لأحداث تاريخية ميتة فى كنيستنا, لأن الماضى بلا شك هو أحد أطراف الزمن, الذى لا يمكن لنا أن نهدمه ونتخلص منه على الإطلاق, فلنحترم إذاً تاريخنا لأنه هو ذاته حىّ فينا بطريقة ما!!
ومحاولتنا لهدمه والتخلص منه هو الموت بعينه, فيسقط زماننا للموت, بسقوط زمانهم الذى ولد زماننا!!
– أما عن حاضرنا فهو غنى بالكثير من صلواتنا, وتخفيفاً على القارئ نكتفى بابسطها كمثال, على ان نعود لعرض منفصل مفصل لحكمة صلواتنا, التى استطاعت وباقتدار المحافظة على إجتماع كنيستنا فعال ومؤثر فى النفوس فى اشد وأحلك الظروف التاريخية, فصلاة “يارب أرحم” وصلت إلينا عابرة كل محن عصور التاريخ, ووصل صداها أيضاً لكافة أرجاء المسكونة. فكنيستنا تعلمنا أن نصلى بها كطلبة فى صياغة الحاضر, كما لو كان الرب لم يرحم بعد!! مع إنها تؤكد فى تعليمها بأن الرب قد أتم عمله بالرحمة الدائمة, إلا أنها فى ذات الوقت تحترم حقوق وإحتياج الأنسان فى طلب الرحمة, فهى لا ترغب فى تجاوز مخل لزمن وجودنا, الذى سيؤدى بحاضرنا إلى الهاوية وبئس المصير.
– أما المستقبل فهو الرجاء الدائم الذى لا ينقطع أبداً, فالعبور الكامل للرب هو إشتياق نفوسنا جميعاً, وله أيضاً الكثير من الإشارات الواضحة التى نرجوها كرجاء دائم قائم فى صلاتنا, والذى لربما لسنا فى حاجة لذكرها.
إذاً وبأختصار لا يمكن بل من المستحيل تجاوز أحد أطراف حياتنا الزمنية, وإلا أنهدمت كنيستنا تماماً, وخربت حياة الأفراد والأسر, لبنة بناء كنيستنا, بل وكل جماعة عاملة فى خدمة الرب.
وهذا ما نلاحظه مع أسرنا أيضاً, فالابن الذى يهمل ماضيه, ولا يتعلم منه, هو ابن عاق!!
والأبن الذى يهمل حاضره, يتشرد ويصير مارقاً!!
والأبن الذى لا يأمل فى مستقبله يتحطم, وأن أستمر فى عدم رؤيته لمستقبله, يمكن أن يصير مجرماً!!
كما أكد أرنست بروخ بأن ” الأحلام هى طريق المستقبل”.
إذاً لا يمكن تجاوز الزمن بأبعاده الثلاثة, وهذا بالطبع يمنعنا من أن نستمتع بالكامل بالمحبة المطلقة الآن, إلا إننا نرجوها من كل قلوبنا, فشكراً للرب الذى يتحنن علينا, فيذيقنا عربونها, ونحن مازلنا فى كامل أجسادنا الترابية.
وهنا نسأل السؤال الواجب:
هل يمكن لكنيستنا أن تتواجد وتستمر إن أخترقت وأحرقت الزمان بنار الروح القدس؟؟
الروح القدس لم يعطى ليقضى على الزمن, بل ليقدس زماننا ومكاننا, ويحافظ عليهما فى قداسة نمونا المتواتر للرب, لينمو الوعى بالحياة الأبدية فى قداسة الحق رويداً رويداً, بجهاد, بنسك, بعرق التخلية, بتمارين محبة تنمو بأستمرار, لتَلُفَ حياتنا كلها بإرادة الرب حتى النفس الأخير. فليعيننا روح الرب على ثقل أجسادنا حتى المنتهى. آمين.
هذا مجرد مقدمة لازمة, لحديث مرتقب عن يقينية خلاصنا.